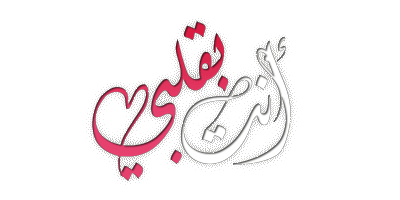[B]مقدمة
[FONT=arial, verdana, helvetica][B]الإمام نور الدين عبدالله بن حميد بن سلُّوم السالمي[/FONT][/B][/B]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير.
لقد كان من عون الله تعالى لنا وعنايته بنا أن وهبنا الصحة والعافية ومنحنا فسحة من الوقت تمكنا من خلالها من إنجاز تحقيق الجزء الثاني من كتاب (( مشارق أنوار العقول )) للإمام نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي.
ولقد تكلمنا في مقدمة الجزء الأول عن الكتاب ومؤلفه بما يغني عن الحديث عنه مرة أخرى، وإن كان هناك من شيء يجب إضافته، فإنه يطيب لنا أن نلقي بعض الأضواء على ما حوته دفتا هذا الجزء من أبواب وفصول مشيرين إلى طريقة المؤلف في عرضها وتبيانها.
بدأ المؤلف حديثه في هذا الجزء عن جواز بعث الرسل والأنبياء، وفيه يستعرض أقوال العلماء والفرق المختلفة، موضحا معتقدهم من هذه القضية مفندا آراءهم، مشيرا لصوابهم كاشفا عن أخطائهم، مبرزا في النهاية الرأي الأمثل والذي يتوافق مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وما كاد المؤلف ينتهي من عرض هذه القضية التي كثرت فيها الآراء وتبادلت فيها الأفكار حتى نراه يعقد فصلا مطولا عن القرآن الكريم يستعرض من خلاله المحكم والمتشابه في كتاب الله تعالى، موضحا أقسام كل منهما مبتعدا عن الرأي العجل مبرأ نفسه عن الهوى والغرض الذي هو آفة بعض العلماء، والذي أدى ببعضهم في النهاية إلى البلبلة والتمزق، وتوسيع هوة الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة.
ثم تناول المؤلف السمعيات بالحديث، وأسهم إسهاما مميزا في توضيح قضية الروح، وعذاب القبر، وتباين الآراء في خلق الجنة والنار، وما يتبع ذلك من قضية البعث والحساب، والميزان والصراط، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهو في كل ذلك مفندا أقوال العلماء مبينا زيفها مشيرا إلى ما فيها من آراء فاسدة، ومعتقدات باطلة يفعل المؤلف ذلك بعد عرض آراء الخصوم كما جاءت عنهم أو نقلت في مؤلفاتهم وكتبهم بلا زيادة أو نقصان.
والكتاب بهذه الصورة يعتبر أحد المراجع الهامة في علم الكلام وذلك باستعراضه للكثير من آراء الفرق الكلامية والتي واكبت تاريخ الفكر الإسلامي، وساهمت مساهمة فعالة في نضجه واكتماله.
نسأل الله العلي القدير أن يجزي مؤلفه جزاء العاملين الذين أجابوا داعي الله، وأخلصوا دينهم لله، وأن يجعل عمله في هذا الكتاب في حسناته يوم القيامة إنه نعم المولى ونعم النصير.
مسقط في 25 جمادى الأولى 1408 هـ.
14 يناير 1988 م
المحقق
د. عبد الرحمن عميرة
رئيس قسم العلوم الإسلامية
بجامعة السلطان قابوس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير.
لقد كان من عون الله تعالى لنا وعنايته بنا أن وهبنا الصحة والعافية ومنحنا فسحة من الوقت تمكنا من خلالها من إنجاز تحقيق الجزء الثاني من كتاب (( مشارق أنوار العقول )) للإمام نور الدين أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي.
ولقد تكلمنا في مقدمة الجزء الأول عن الكتاب ومؤلفه بما يغني عن الحديث عنه مرة أخرى، وإن كان هناك من شيء يجب إضافته، فإنه يطيب لنا أن نلقي بعض الأضواء على ما حوته دفتا هذا الجزء من أبواب وفصول مشيرين إلى طريقة المؤلف في عرضها وتبيانها.
بدأ المؤلف حديثه في هذا الجزء عن جواز بعث الرسل والأنبياء، وفيه يستعرض أقوال العلماء والفرق المختلفة، موضحا معتقدهم من هذه القضية مفندا آراءهم، مشيرا لصوابهم كاشفا عن أخطائهم، مبرزا في النهاية الرأي الأمثل والذي يتوافق مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وما كاد المؤلف ينتهي من عرض هذه القضية التي كثرت فيها الآراء وتبادلت فيها الأفكار حتى نراه يعقد فصلا مطولا عن القرآن الكريم يستعرض من خلاله المحكم والمتشابه في كتاب الله تعالى، موضحا أقسام كل منهما مبتعدا عن الرأي العجل مبرأ نفسه عن الهوى والغرض الذي هو آفة بعض العلماء، والذي أدى ببعضهم في النهاية إلى البلبلة والتمزق، وتوسيع هوة الخلاف بين أبناء الأمة الواحدة.
ثم تناول المؤلف السمعيات بالحديث، وأسهم إسهاما مميزا في توضيح قضية الروح، وعذاب القبر، وتباين الآراء في خلق الجنة والنار، وما يتبع ذلك من قضية البعث والحساب، والميزان والصراط، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهو في كل ذلك مفندا أقوال العلماء مبينا زيفها مشيرا إلى ما فيها من آراء فاسدة، ومعتقدات باطلة يفعل المؤلف ذلك بعد عرض آراء الخصوم كما جاءت عنهم أو نقلت في مؤلفاتهم وكتبهم بلا زيادة أو نقصان.
والكتاب بهذه الصورة يعتبر أحد المراجع الهامة في علم الكلام وذلك باستعراضه للكثير من آراء الفرق الكلامية والتي واكبت تاريخ الفكر الإسلامي، وساهمت مساهمة فعالة في نضجه واكتماله.
نسأل الله العلي القدير أن يجزي مؤلفه جزاء العاملين الذين أجابوا داعي الله، وأخلصوا دينهم لله، وأن يجعل عمله في هذا الكتاب في حسناته يوم القيامة إنه نعم المولى ونعم النصير.
مسقط في 25 جمادى الأولى 1408 هـ.
14 يناير 1988 م
المحقق
د. عبد الرحمن عميرة
رئيس قسم العلوم الإسلامية
بجامعة السلطان قابوس

 أن العقل لا يدرك من التكاليف إلا بعضها ، فلا يدرك ما كان كالصلاة ووظائفها والصوم ووظائفه ونحو ذلك ، فلا غنى عن الرسول به ولو سلمنا أنه يدرك ذلك لكان إدراكه له متفاوتا محتاجا إلى مدة طويلة ، وربما وقع في مهلكة قبل إدراكه لها فالرسول كالطبيب الحاذق الذي يعرف الداء والدواء وطبائع الأدوية ، فيخبر الناس أن هذا لكذا وهذا لكذا وذا لكذا ، فإنه وإن أمن أن الناس يدركون طبائع تلك الأدوية وأسرارها بمحض التجربة فلربما وقعوا في مدة تجربتهم لها في الدواء القاتل لهم فظهرت حكمة وجود الطبيب لهم.
أن العقل لا يدرك من التكاليف إلا بعضها ، فلا يدرك ما كان كالصلاة ووظائفها والصوم ووظائفه ونحو ذلك ، فلا غنى عن الرسول به ولو سلمنا أنه يدرك ذلك لكان إدراكه له متفاوتا محتاجا إلى مدة طويلة ، وربما وقع في مهلكة قبل إدراكه لها فالرسول كالطبيب الحاذق الذي يعرف الداء والدواء وطبائع الأدوية ، فيخبر الناس أن هذا لكذا وهذا لكذا وذا لكذا ، فإنه وإن أمن أن الناس يدركون طبائع تلك الأدوية وأسرارها بمحض التجربة فلربما وقعوا في مدة تجربتهم لها في الدواء القاتل لهم فظهرت حكمة وجود الطبيب لهم.