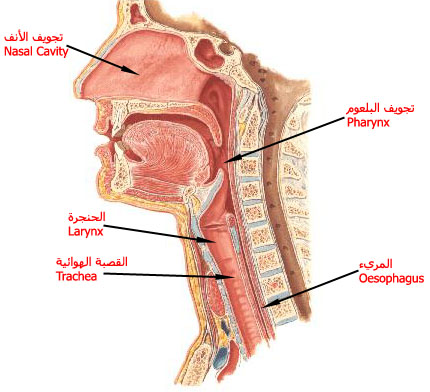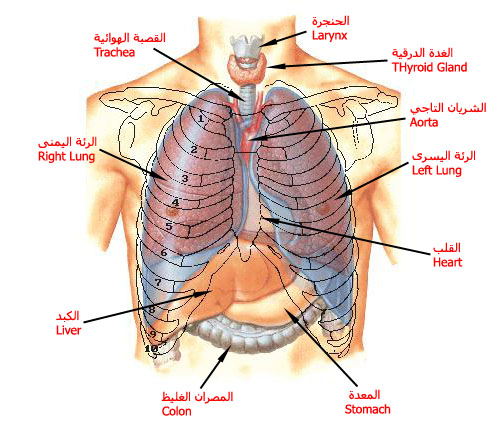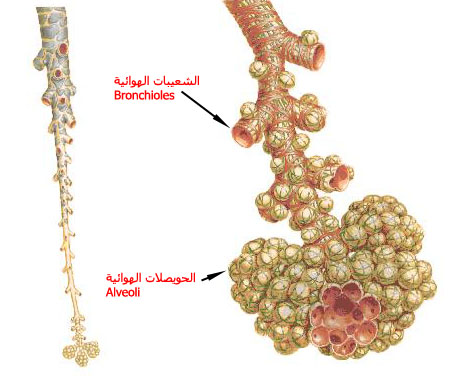تفضلوا يا اخوان البحث يمكن تستفيدوا منه
وشكرا
اي بحث ودكم اليه اكتب اسمه ولا يهمكم ان شاء الله اجيبه لكم
[line]
ستجدون هنا حتى الآن العناوين الآتية :
*جابر بن حيان
*طه حسين
*التنفس ( التنفس الاصطناعي – امراض التنفس – الجهاز التنفسي
*الجغرافيا البشرية
*خليل مطران
*علم الجغرافيا
*الآثار العمانية
*الإيدز
*عمر بن الخطاب
*علم البلاغة
*المتنبي
*مصعب بن عمير
*التربية الجمالية في الإسلام
*الحجاج بن يوسف الثقفي
*سعيد بن جبير
*علم الجغرافيا
*الضغط ( فيزياء )
*أحمد شوقي
*الاستنساخ
*عمان في العصر العباسي
*علم الفيزياء
*علم الكيمياء
جابر بن حيان
ولد جابر بن حيان في طوس سنة 120 هــ -737م ، وتوفي سنة 198هــ _813م
اشتهر جابر بن الحيان بالعلوم ولا سيما الكيمياء ، له في الكيمياء والمنطق والفلسفة الكثير من المؤلفات والمصنفات المشهورة والتي ضاع معظمها ولم يبق منها غير ثمانين كتابا ورسالة . وفي المكتبات العامة والخاصة سواء في الشرق والغرب ،وقد تم ترجمة بعض المؤلفات إلى اللغة اللاتينية وكان ذلك له الأثر الكبير
في تكوين مدرسة كيميائية في الغرب ذات اثر فعال.
ولقد اعتراف الغرب بفضل جابر فقال (ليكارل) في كتابه تاريخ الطب العربي : إن جابر من اكبر العلماء في القرون الوسطى وأعظم علماء عصره وكذلك يعترف (سارطون ) بفضل جابر ويقول انه كان شخصية فذة ومن أعظم الذين برزوا في ميدان العلم في القرون الوسطى ، وكان جابر شديد الشغف بالكيمياء فقد درسها دراسة وافية ووقف على ما انتجة السبابقون . وقد جعل الكيمياء تقوم على تجربة والملاحظة والاستنتاج ، كل هذه العوامل جعلت اسم جابر بن الحيان من الخالدين في التاريخ الكيميائي .
ولقد عدل جابر في نظرية (أرسطو) التي تتحدث عن تكوين الفلزات وجعلها أكثر ملاءمة للحقائق العلمية المعروفة وكتاب ذلك في كتابه الإيضاح وخارج بذلك بنظرية جديدة عن تكوين الفلزات .
وابتكر جابر علم الوازين في الكيمياء ، وأول من استحضر حــامض الكبريتيك بتقطيره من الشبة وسماه (زيت الزاج) وكان لجابر بن الحيان الأثر الكبير في الكيمياء والطاقة .
وقد استحضر أيضا حامض النيتريك ، وأول من كشف الصودا الكاوية وأول من استحضر ماء الذهب وأول من فصل الذهب عن الفضة بواسطة الحامض .
وهو أول من لاحظ ما يحضر من راسب (كلوريد الفضة) وكذلك ينسب اليه تحضير المركبات مثل كوبونات البوتاسيوم وكوبونات الصوديوم ، وكذلك درس خصائص المركبات الزئبقية وتحضيره .
وله كتاب عن السموم (كتاب السموم ودفع مضارها) وقد ذكر فيه وأسرار وأقوال الفلاسفة اليونان في السموم ،
كما تضمن الكتاب تقسيمات لأنواع السموم وينقسم الكتاب الى فصول:
الاول : يذكر فيه اوضاع القوى الاربع وحالتها مع الادوية المسهله والسموم القاتلة .
الفصل الثاني : في اسماء السموم ومعرفة الجيد منها والردئ .
الفصل الثالث :في ذكر السموم العامه الفعل في سائر الابدان .
الفصل الرابع : في علامات السموم المسقاة والحوادث العارضة .
الفصل الخامس : في ذكر السموم المركبة .
الفصل السادس : في الاحتراس من السموم قبل اخذها وذكر الادوية النافعة من السموم .
وبعد ان بين جابر بن الحيان انواع السموم ، فقد قسمها الى حيوانية ونباتية وحجرية ، وذكر في السموم الحيوانية مرارة الافـاعي ومراره النمر ولسان السحلفاة والضفدع والعقارب .
ومن السموم النباتية قرون السنبل والافيون والشليم والحنضل والشكوران .
ومن السموم الحجرية الزئبق والزرنيخ والزاج وبرادة الحديد والطلق وبرادة الذهب .
وقد دعا جابر الى الاهتمام بالتجربة ، وحث على اجرائها مع دقة الملاحظة ، وقد قال : ان واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل واجراء التجربة , وان المعرفة لا تحصل الا بها .
وقد وفق جابر بن الحيان في عمليته الكيميائية كالتبخير والتقطير والتكليس والاذابة والتبلور .
ومن كتب جابر بن الحيان كتاب الجمع وكتاب الاستتمام وكتاب الاستيفاء وكتاب التكليس .
وكان ذالك سببأ في اعتراف علماء اوروبا بفضل جابر بن الحيان فى هذا المجال ولقد قال عنه (برتيلو):
"لجابر بن حيان في الكيمياء ما لاسطو طاليس في ....." .
[line]
جابر بن حيان وعلم الكيمياء (علم الصنعة)
ملخص البحث
هذا البحث المبسط والموجز يكشف عن صفحة مشرقة من صفحات تراثنا العلمي العربي، ويبيّن ما للعرب من أصالة في التراث العلمي والإنساني الذي استقى منه التراث العالمي فترة طويلة من الزمن. فإذا تجاوزنا العلوم التي أبدع فيها العرب إلى علم الكيمياء الذي يهمنا في هذا البحث، نرى أن العرب قد ابتكروا كثيراً في حقل الكيمياء معتمدين على البحث التجريبي الذي يعدون فيه رواداً نحو الحقيقة وعلى رأس هؤلاء الرواد العالم العربي المتصوف جابر بن حيان الذي تضاربت الآراء والأقوال حول وجوده وحقيقته. فكأنما الإنسانية تستكثر على نفسها أن يظهر من أبنائها واحداً يتجاوز بنبوغه حداً معقولاً. وتشكل مجموعة الكتب الكثيرة التي تحمل اسم جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما توصل إليه الكيميائيون العرب حتى عصره، وتنم عن اطلاعه الواسع وتجاربه العلمية، وأهم هذه الكتب: نهاية الإتقان، الميزان، السموم، وكتب أخرى كثيرة، وآخرها كان كتاب الرحمة الذي وجد تحت رأسه عندما مات.
من جملة ما اهتم به جابر (واهتم به الأسبقون وكان غاية الحكماء) هو إمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب (علم الكيمياء أو علم الصنعة)، بالإضافة إلى الحصول على حجر الحكماء أو حجر الفلاسفة أو ما يدعى بالإكسير، وهذا ما سيتناوله هذا البحث الموجز.
مقدمة:
اختلف مؤرخو العلم حول أصل كلمة كيمياء. فمنهم من ردها إلى الفعل اليوناني chio الذي يفيد السبك والصهر، ومنهم من أعادها إلى كلمتي chem , kmt المصريتين ومعناهما الارض السوداء، ومنهم من يرى أنها مشتقة من كلمة كمى العربية أي ستر وخفى ].
ويعرّف ابن خلدون الكيمياء بأنها (علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة)، ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك
لقد تأثرت الكيمياء العربية بالكيمياء اليونانية والسريانية وخاصة بكتب دوسيوس و بلنياس الطولوني الذي وضع كتاب (سر الخليقة). غير أن علوم اليونان والسريان في هذا المجال لم تكن ذات قيمة لأنهم اكتفوا بالفرضيات والتحليلات الفكرية.
وتلجأ الكيمياء إلى الرؤية الوجدانية في تعليل الظواهر، وتستخدم فكرة الخوارق في التفسير، وترتبط بالسحر وبما يسمى بعلم الصنعة، وتسعى إلى تحقيق هدفين هما:
أ – تحويل المعادن الخسيسة كالحديد والنحاس والرصاص إلى معادن شريفة كالذهب والفضة عن طريق التوصل إلى حجر الفلاسفة.
ب – تحضير أكسير الحياة، وهو دواء يراد منه علاج كل ما يصيب الإنسان من آفات وأمراض، ويعمل على إطالة الحياة والخلود.
وهذان الهدفان سـنناقشـهم في هذا البحث من وجهة نظر وعمل أبي الكيمياء العالم العربي جابر بن حيان.
تطور علم الكيمياء عند القدماء:
إن تاريخ الكيمياء في العالم القديم أكثر غموضاً من تاريخ الفيزياء، ونحن لا نعلم من تاريخ الكيمياء إلا النتائج العملية، ولم يدوّن لنا القدماء من ذلك التاريخ شيئاً
يمكن اعتبار الكيمياء الصينية أقدم المعارف الكيميائية، لكن لايزال السؤال غامضاً عن صلة الوصل بين الكيمياء الصينية والكيمياء المصرية القديمة، وهذا ما حاول الباحث جونسون Jhonson أن يبرهن عليه، حيث ذكر عن كاتب صيني قديم يرجع عهده إلى سنة 330 ق. م أنه حرّر عن الفلسفة التاتوئية والسيمياء، والأخيرة تحتوي على كيفية تحويل المعادن إلى معادن ثمينة، وكيفية الحصول على إكسير الحياة، تلك المادة التي تطيل الحياة على زعمهم وتقضي على الموت .
وقد قال ابن النديم أنه زعم أهل صناعة الكيمياء، وهي صناعة الذهب والفضة من غير معادنها، أن أول من تكلم عن علم الصنعة هو هرمس الحكيم البابلي المنتقل إلى مصر عند افتراق الناس عن بابل، وإن الصنعة صحّت له، وله في ذلك عدة كتب، وإنه نظر في خواص الأشياء وروحانيتها.
وزعم الرازي أن جماعة من الفلاسفة عملوا في الكيمياء مثل: فيثاغورس، ديموقراط، أرسطاليس، جالينوس، وغيرهم، ولايجوز أن يسمى الإنسان فيلسوفاً إلا أن يصح له علم بالكيمياء.
وقال آخرون أن علم الكيمياء (قديماً) كان بوحي من الله عز وجل إلى موسى بن عمران (قصة قارون).
الكيمياء في القرون الوسطى:
أشهر شخصية من شخصيات الكيمياء الغربية في القرون الوسطى وخاصة التي تناولت فكرة الحصول على الذهب هو العالم برنارد تريفيزان Bernard Trevisan حيث رافقت هذا المغامر في الكيمياء فكرة البحث عن الذهب في الصخور والأحجار والمعادن والاملاح وغير ذلك.
سافر إلى بلاد الإغريق والتتار والقسطنطينية وزار مصر، لكنه لم يمس تبرها.
خامرت العالم برنارد فكرة الحصول على الذهب من الإنسان لأنه تاج الخليقة، ويشكل الذهب ذروة الكمال المعدني، وأراد أن يحل مشكلته الكبرى في أشعة الشمس للاعتقاد السائد قديماً بأن هذه الأشعة هي التي تكون المعادن، وما الذهب إلا أشعة الشمس المتكاثفة التي استحالت إلى جسم أصفر براق.
واعتقد بنمو المعادن، حتى أن أصحاب المناجم كانوا يغلقون مناجمهم برهة من الزمن ليعطوا المعادن فرصة التكون. وقد بدد ثروته الهائلة على تلك الافكار .
علم الكيمياء عند العرب المسلمين:
بدأت الكيمياء في الإسلام بالصنعة، ذلك لأن العرب اعتمدوا الكتب المنقولة عن اليونانية، وكتب الإسكندرانيين التي نقلت إلى العربية. ويعتبر خالد بن يزيد بن معاوية أول من اشتغل في علم الصنعة عند العرب، حيث استقدم بعض الرهبان الأقباط المتفحصين بالعربية، كمريانوس، شمعون، وغيرهم، وطلب إليهم نقل علوم الصنعة إلى اللغة العربية عله يتمكن من تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب.
وهكذا وصلت الصنعة إلى العرب بواسطة الإسكندرانيين ممتزجة بالأوهام والأضاليل، تهدف إلى تحقيق غايات وهمية تتعلق بالصحة والخلود والثروة بعيدة عن الكيمياء التي ترتكز على قواعد وقوانين علمية.
وقد انتقل هذا المفهوم إلى العلماء العرب فاعتقدوا كاليونان والسريان أن طبائع العناصر قابلة للتحويل، وأن جميع المعادن مؤلفة من عناصر واحدة هي الماء، الهواء، التراب، النار، وسبب اختلافها فيما بينها يعود إلى اختلاف نسب هذه العناصر في تركيبها، فلذلك لو توصلنا إلى حلّ أي معدن إلى عناصره الأساسية، وأعدنا تركيبه من جديد بنسب ملائمة لنسب أي معدن آخر كالذهب والفضة مثلاً، لاستطعنا الحصول على هذا المعدن.
من أجل ذلك قام العلماء العرب بتجارب عديدة، أحاطوها بالسرية التامة، واستعملوا الرموز في الإشارة إلى المعادن فأشاروا إلى الذهب بالشمس، والى الفضة بالقمر، فاكتشفوا مواد جديدة، واختبروا أموراً مختلفة، وتوصلوا إلى قوانين عديدة، واستطاعوا أن ينقلوا الخيمياء إلى الكيمياء وذلك لعدة أسباب منها:
1- فشل محاولات الصنعة في تحقيق أهدافها، وتحولها إلى علم تجريبي على يد العالم جابر بن حيان ومن ثم الرازي.
2- تكثيف التجارب المادية والتماس منهج علمي صحيح قائم على التجربة والبرهان.
ومع جابر بن حيان انتقلت الكيمياء عن العرب من طور صنعة الذهب الخرافية إلى طور العلم التجريبي في المختبرات.
جابر بن حيان:
ترتبط نشأة الكيمياء عند العرب بشخصية أسطورية أحياناً وتاريخية حيناً آخر، هي شخصية جابر بن حيان، ونستنتج من خلال الكتب التي تحمل اسمه أنه من أشهر الكيميائيين العرب، ويعدّ الممثل الأول للكيمياء العربية.
وقد أثّر جابر في الكيمياء الأوربية لظهور عدد لا يستهان به من المخطوطات اللاتينية في الكيمياء منسوبة إلى جابر بن حيان .
مولده – نشأته:
هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي المعروف بالصوفي. ولد في طوس (خراسان ) وسكن الكوفة، حيث كان يعمل صيدلانياً. وكان أبوه عطاراً. بنسبته الطوسي أو الطرطوسي، وينحدر من قبيلة الازد.
يقال إنه كان من الصابئة، ومن ثم لقبه الحرّاني، كان من أنصار آل البيت (بعد أن دخل الإسلام وأظهر غيرة عظيمة على دينه الجديد )، ومن غير الموالين للدولة العباسية في بداية حياته .
كان يعيش في ستر وعزلة عن الناس فقيل عنه إنه كان صوفياً.
ويقدّر الزمن الذي ولد فيه جابر بين 721 م – 722 م، أما تاريخ وفاته فغير معروف تماما. ويقال أنه توفي سنة 200 هـ أو ما يوافق 815 م .
ويقول هولميارد Holmyard أن جابر عاش ما يقارب 95 سنة، ودليله في ذلك أن المؤلفات التي ألّفها لا يمكن إنجازها بأقل من هذا الزمن.
رحل إلى الجزيرة العربية وأتقن العربية وتعلّم القرآن والحساب وعلوماً أخرى على يد رجل عرف باسم (حربي الحميري) وقد يكون هو الراهب الذي ذكره في مصنفاته وتلقّن عنه بعض التجارب.
اتصل بالإمام جعفر الصادق (الإمام الخامس بعد علي بن أبي طالب ) ت 148 هـ، ويقال إنه أخذ علم الصنعة عنه، وتتلمذ على يديه، وعن طريقه دخل بلاط هارون الرشيد بحفاوة.
اختلاف الرواة والمفكرين في أمره ووجوده:
اختلف الرواة في أمر جابر، فقد أنكر قوم أن يكون قد مرّ في هذه الحياة رجل يحمل هذا الاسم، وقال آخرون إنه رجل معروف في التاريخ، وقد اشتغل بصناعة الكيمياء، واستطاع أن يحوّل المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة.
وزعم قوم من الفلاسفة أنه منهم، وله كتب في المنطق والفلسفة. وزعم آخرون ( أهل صناعة الذهب والفضة) أن الرئاسة انتهت إليه في عصره وأن أمره كان مكتوماً.
لكن جابر بن حيان حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، وعلم من أعلام العرب العباقرة، وأول رائد للكيمياء، وقد أيّد هذه الحقيقة أبو بكر الرازي، عندما كان يشير إلى جابر في كتبه فيقول "أستاذنا.
مدرسته:
أخذ جابر مادته الكيمياء من مدرسة الإسكندرية التي كانت تؤمن بانقلاب العناصر، وقد كان تطورها من النظريات إلى العمليات. وقد درس جابر ما خلّفه الأقدمون، فلم يرَ من تراثهم من الناحية الكيميائية إلا نظرية أرسطو عن تكوين الفلزات، وهي نظرية متفرعة عن نظريته الأساسية في العناصر الأربعة: الماء، الهواء، التراب، النار.
ولم يعرف فقط كبار مفكري وعلماء العالم اليوناني، بل كان يعرف الكتب ذات المحتوى السري جداً مثل كتب أبولينوس التيتاني. وزعم هولميارد أن المصدر الذي استقى منه جابر علومه في الكيمياء هو الأفلاطونية الحديثة.
منهجه العلمي:
العلم عند جابر يسبق العمل، فليس لأحد أن يعمل ويجرب دون أن يعلم أصول الصنعة ومجالات العلم بصورة كاملة وقد قال: "إن كل صنعة لابد لها من سبوق العلم في طلبها للعمل".
وقطع جابر كأحد رواد علماء العرب خطوة أبعد مما قطع اليونان في وضع التجربة أساس العمل لا اعتماداً على التأمل الساكن، ولعله أسبق عالم عربي في هذا المضمار، فنراه يقول:
] وملاك هذه الصنعة العمل، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبداً [.
وقد كان جابر انطلاقاً من قناعته بامكانية قيام العلم الطبيعي على قاعدة الاتقان المتين، كان شجاعاً بما فيه الكفاية، فهو يؤمن بأنه انتزع من الطبيعة آخر خفاياها، سمة علمه أنه لا يعترف بوجود أي حد للتفكير البشري.
تساءل جابر ؟! ألا يمكن أن يكون التوليد ممكناً، ] فالكائن الحي بالنسبة له بل الانسان نفسه، إنما هو نتيجة تفاعل قوى الطبيعة، فمن الممكن من الناحية النظرية على الأقل- محاكاة تدبير الطبيعة بل تحسينه عند الحاجة [.
ومهما يكن من أمر، فإن قيام جابر كعالم كيميائي ابتكر المنهج التجريبي في الكيمياء، لايعني أن هذا العالم قد تخلص من الافكار القديمة، وحرّر فكره ومذهبه منها، إذ أن له بعض الكتابات الغريبة والطلسمات، لكن هذا لايعني أيضاً أنه لم يشق طريقه في الظلمات عبر العصور المظلمة إلى النور.
ولجابر الكبير في تطور الكيمياء وانتقالها من صنعة الذهب الخرافية إلى طور العلم التجريبي في المختبرات، حيث أن موضوع الحصول على الذهب لم يشغله عن غيره من النواحي العلمية الاخرى، فشمل نشاطه المسائل النظرية والعلمية العادية وغير العادية.
فقد عرف جابر الكثير من العمليات العلمية كالتقطير، التبخير، التكليس، الإذابة، التبلور، وغيرها [27].
كما شمل عمله الناحية التطبيقية للكيمياء، من ذلك أنه أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض، وهذه طريقة لا زالت مستخدمة حتى الان، ولها شأن في تقدير عيارات الذهب في المشغولات والسبائك الذهبية [28].
رأي جابر في طبائع العناصر، وإمكانية تحويلها إلى ذهب:
ينطلق جابر في الصنعة من أن لكل عنصر روحاً (نفساً، جوهراً ) كما نجد في أفراد الناس والحيوان، وأن للعناصر طبائع، وهذه الطبائع في العناصر قابلة للتبدل.
ويرى جابر أن العنصر كلما كان أقل صفاءً (ممزوجاً بعناصر اخرى ) كان أضعف تأثيراً، فإذا أردنا عنصراً قوي الاثر (في غيره)، وجب تصفيته، والتصفية تكون بالتقطير، فبالتقطير تصعد الروح من العنصر فيموت العنصر. يقول جابر:
] فإذا استطعنا أن نسيطر على روح هذا العنصر، ثم القينا شيئاً منه ( الروح وهي مذكر) على مادة ما، انقلبت تلك المادة فكانت مثل العنصر الذي القينا فيه شيئاً من روحه [ [29].
تطبيق هذا الرأي على الذهب:
يقول جابر:
] إن أصفى العناصر الحاضرة الذهب، لكن صفاءه غير تام، فيجب أن نصفّيه مرة بعد أخرى، حتى نبلغ به درجة الصفاء المطلقة، ونستخرج روحه في ايدينا إكسيراً أو دواءً، يعمل في المعادن عمل الخميرة في العجين [.
فكما أن الخميرة تجعل العجين الفطير كله عجيناً مختمراً، فكذلك الاكسير (الاحمر المستخرج من الذهب ) يقلب المعادن ذهباً، والاكسير (الابيض المستخرج من الفضة) يقلب المعادن فضة.
أما العناصر التي تقبل عند أصحاب الصنعة الانقلاب ذهباً وفضة (بسهولة ) فهي النحاس والزئبق والرصاص والحديد [30].
ويبدو أن (الروح، الخميرة، الاكسير، حجر الفلاسفة، الكيمياء ) اسماء مختلفة لشيء واحد.
فالاكسير برأي جابر يمكن الحصول عليه بغلي الذهب في سوائل مختلفة مرة بعد مرة ألف مرة، ولا شك في أن هذا الزعم باطل [31].
ولجابر رأي روحاني متطرف في طبائع المعادن (ذكر ذلك في كتاب الرحمة)، فهو يعد المعدن كائناً حياً ينمو في باطن الارض أمداً طويلاً آلاف السنين، وينقلب من معدن خسيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب، وغاية علم الكيمياء الاسراع بهذا الاقلاب، وهو يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل والتعليم على المعدن، وكذلك مذاهب الحياة والموت [32].
كان جابر يرى أن المعادن تحت تأثير الكواكب، تتكون في الارض من اتحاد الكبريت الحار واليابس مع الزئبق البارد والرطب.
ويرجع وجود المعادن بأنواع مختلفة إلى أن الكبريت والزئبق ليسا نقيين على الدوام، ولأنهماً فضلاً عن ذلك لايتحدان بالنسب ذاتها، فإذا كانا نقيين تماماً، وحصل الاتحاد كاملاً بالميزان الطبيعي، نشأ الذهب أكمل المعادن [33].
أما الاخلاط والنسب غير الكاملة فتؤدي إلى تكوين الفضة أو الاسرب أو الحديد أو النحاس. ولما كان لهذه المعادن في الاصل التركيب ذاته الذي للذهب، فيمكن تصحيح (تأثير) المصادفات في طريقة تركيبها بتدبير مناسب، وهذا التدبير يُشكّل غرض الصنعة، ويعول على استعمال الاكاسير [34].
ومن هنا نستنتج أن جابراً يرى أنه من غير المستحيل تكوين الذهب نظرياً على الاقل، وإن كان ذلك صعباً تجريبياً ! [35].
تدبير جابر للأكاسير:
من أهم جوانب علم الكيمياء عند جابر، استناده على الاكسير العضوي، بالاضافة إلى الإكسير غير العضوي.
فمن العلامات المميزة في الصنعة عند جابر تدبير الأكاسير لا على أساس معدني فحسب، بل كذلك على اساس مواد حيوانية ونباتية، بل إنه يفضل الاكسير الذي يرجع إلى مواد حيوانية، لما لهذه المواد من فعل أقوى بكثير مما للاكاسير الاخرى.
يرى جابر أنه يمكن عمل اكاسير مختلطة بهذه المواد المذكورة، من ذلك مثلاً إكسير نباتي – حيواني، إكسير نباتي - معدني، إكسير حيواني – معدني، إكسير نباتي - حيواني – معدني.
ولايمكن بلوغ هذه الاكاسير المختلفة، وكذا الاكسير الاعظم، أي العقار العام لكل المعادن [36].
ولا بد للحصول على الاكسير الصحيح من الرجوع إلى اصول أكيدة، واستيفاء كل أسباب الدقة.
وقد اعتمد جابر في ذلك على فكرة أن كل الاشياء في العالم الطبيعي تتركب من عناصر اربعة، تشكلت بدورها من أربع كيفيات.
ومن الممكن عن طريق (الميزان) معرفة نصيب الطبائع الاربع في كل جسم، وبالتالي تجديد تركيبه بدقة تامة.
وبهذه الطريقة يمكن للكيميائي أن يتحكم في كل التغيرات التي تحصل في الجسم، ما دام في وضع يدبر فيه كلاً على حدة الاصول والكيفيات التي تعمل بها الطبيعة، كما يصبح في وضع يمكنه من تدبير أجسام جديدة، وبخاصة اكاسير مختلفة تفعل في المعادن [37].
وما الصور المختلفة للاكاسير إلا مزائج تجانست قليلاً أو كثيراً، مع الطبائع أو الخواص الاربع، مزائج تتفق مع تركيب الاجسام التي استعملت عليها.
وها هو ذا تحديد عمل الاكسير كما بيّنه جابر نفسه في كتاب السبعين:
إن الاصول الاربعة العاملة في الاجسام من الاجناس الثلاثة المؤثرة فيها والمحددة لصبغها هي: النار، الماء، الهواء، الارض.
وفي الواقع ليس هناك فعل واحد من هذه الثلاثة أجناس إلا بتلك العناصر الاربعة. ولهذا، كان معولنا في هذه الصناعة على تدبير هذه العناصر، نقوّي ضعيفها، ونضعّف قويها، ونصلح فاسدها. فمن وصل إلى عمل هذه العناصر الاربعة في هذه الثلاثة أجناس، فقد وصل إلى كل علم، وادرك علم الخليقة وصنعة الطبيعة [38].
يقول جابر في كتابه السبعين على سبيل المثال:
إن الاسرب بارد يابس في الظاهر، وحار رطب في الباطن، وكذلك بالنسبة للفضة، بينما الذهب حار رطب في الظاهر، وبارد يابس في الباطن [39].
ويقال أن جابراً كان أكثر مقامة في الكوفة، وبها كان يدبر الاكسير لصحة هوائها [40].
وذكر جابر في كتابه (الخواص الكبير)، قصة اتصاله بيحيى البرمكي، وعمل اكسيره، وكيف خلصّ به كثيراً من الناس وشفاهم !.
تطلعنا قصته هذه، على أن جابراً كان طبيباً، وكان يستخدم في العلاج دواء يسميه الاكسير، يبدو أنه كان يشفي كثيراً من العلل [41].
أما ما له علاقة بالاكسير من جهة المسؤولية الكبرى، واكتشاف سر الله الاعظم، فله علاقة بالامام جعفر علاقة شديدة [42].
فجابر يعتقد بوجود طريقتين لادراك الصنعة:
أ – طريق ظاهري: وذلك باقتفاء أثر الطبيعة.
ب – طريق باطني : بمعرفة الفرضيات الكبرى، وتطهير النفس البشرية.
والثاني يشير إلى تصوفه وتشيعه الواضحين
[43]. إذ أن أهم مصادر معرفته، الالهامات الباطنية التي اقتبسها عن إمامه جعفر الصادق، فعلاقته مع الامام جعفر الصادق هي علاقة فكرية فلسفية.
والعلاقة بين جابر وإمامه الصادق لا تقف عد حد واحد، إنما تتعداه إلى أمر كشف سر الله الاعظم ألا وهو الاكسير ؟! [44].
] ولن أشير أكثر إلى العلاقة بين العالم جابر بن حيان وإمامه جعفر الصادق لسعة البحث في هذا الامر، ولاختصار دراستنا على جانب علمي معين في علم العالم الكيميائي جابر بن حيان [.
اكتشافات جابر الكيميائية الاخرى:
سنذكر بعضاً منها:
1- عرف جابر بأن الشب يساعد على تثبيت الاصباغ في الاقمشة، والعلم الحديث اثبت ذلك، (الشب = أملاح الالمنيوم).
2- توصل جابر إلى تحضير بعض المواد التي تمنع البلل عن الثياب، وهذه المواد هي أملاح الالمنيوم المشتقة من الحموض العضوية.
3- توصل إلى استخدام كبريتيد الانتموان، الذي له لون الذهب، ليعوّض عن الاخير الغالي الثمن.
4- تمكن من صنع ورق غير قابل للاحتراق، والعلم الحديث لايعرف حتى الان نوع هذا الورق [45].
5- أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض (الماء الملكي) وهذه الطريقة لازالت مستخدمة حتى الان.
6- مارس كثيراً من العمليات الكيميائية، كالتقطير، التكليس، التبلور، التصعيد، وعرف واكتشف الكثير من المواد الكيميائية [46].
لمحة عن كتبه:
ألفّ جابر عدداً كبيراً جداً من الكتب، يقال أنها تجاوزت – 3900 كتاب – [47]، كانت سبباً في الشك بوجوده، أو حتى نسبها جميعاً إليه.
له كتب في الكيمياء، الفلسفة، التنجيم، الرياضيات، الموسيقى، الطب والسحر ورسائل دينية اخرى.
تميّزت مخطوطاته وكتبه بوحدتها، مما يدل على أنها تابعة لمدرسة واحدة، والكتب التي تغلب عليها نزعة الكيمياء هي كتب السبعين والرحمة، أما الكتب التي تغلب عليها النـزعة الطبية فهي رسائل السموم [48].
ولجابر أسلوب لايشبه أسلوب باقي المؤلفين، فأسلوبه يتميز بالجدية، والفكرة الواحدة والتفكير العميق [49].
وقد ذكر ابن النديم ما يزيد عن 360 مؤلفاً لجابر، يمكن الرجوع اليها في كتاب الفهرست [50]، وكذلك ذكرها كرواس في مؤلفه رسائل جابر [51].
يمكن أن نعدّ رسائل جابر في الكيمياء أول مظهر من مظاهر الكيمياء في المدنية الاسلامية، على الرغم من أن عدداً عظمياً من رسائله كان نصيبها الفناء، بينما بقيت بعض الكتب اللاتينية التي أُخذت عنها.
تلاميذه:
قال ابن النديم: أسماء تلامذته (الخرقي ) الذي ينسب اليه سكة الخرقي بالمدينة، (وابن عياض المصري )، و(الاخميمي) [52].
ويقول الرازي في كتبه المؤلفة في الصنعة:
] قال استاذنا أبو موسى جابر بن حيان [، ومراده بقوله استاذنا، أنه استفاد من مؤلفاته، لا أنه تعلم منه، لأن عصر الرازي متأخر عنه كما هو معلوم [53].
مشاهير العلماء الآخرين في الكيمياء:
ورأيهم في مسألة تحويل المعادن الخسيسة إلى ثمينة ؟
أ - الكندي: ت 252 هـ / 866م
يعتبر الكندي أول من اتحذ موقفاً سلبياً من مسألة تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب أو فضة، وقال باستحالة ذلك، ووضع رسالة في (بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخداعهم ) [54].
ب – الرازي: ت 321 هـ / 942 م
برع في الكيمياء كما برع في الطب، ووضع الرازي كتباً عديدة في الكيمياء، ويبدو فيها غير مقتنع بتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة تارة، وتارة أخرى تظهر الكتب اقتناعه بذلك، منها كتاب محنة الذهب والفضة، وكتاب الاسرار [55].
جـ – ابن سينا: ت 428 هـ / 1037 م
لم يضع أي مؤلف بهذا الشأن، له كتاب في بطلان الكيمياء والرد على اصحابها [56].
في مستهل القرن الحادي عشر الميلادي، مرّ على الكيمياء فترة من الجمود استمرات حوالي القرنين حتى أتى عالم من العراق اسمه السماوي.
د – محمد بن أحمد العراقي السماوي:
أشهر مؤلفاته كتاب المكتسب في زراعة الذهب، ودافع فيه عن امكانية تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، واعتمد في طريقته على وصف الاكسير على العالم جابر بن حيان ومن شايعه [57].
هـ – اخوان الصفا: قرن رابع هجري / عاشر ميلادي
اعتقد اخوان الصفا، أن بعض المعادن يستحيل إلى بعض، لكن في باطن الارض، في أزمان طويلة مختلفة الطول، لا على يد الانسان في وقت قصير. ولم يتكلموا عن قلب المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة [58].
رأي العلماء والمفكرين في جابر بن حيان:
كيف تمكن جابر من تأسيس مثل هذا العلم الواسع ؟؟
سؤال دار في الاذهان، وشغل عقول بعض الباحثين والمفكرين، وجعل البعض ينفي وجود مثل هذا الشخص بينما قبل البعض الآخر فيه، بافتراض وجود مدرسة للكيمياء، تمكنت من القيام بهذا العمل على مدى مئة عام من أواسط القرن الثالث إلى أواسط القرن الرابع للهجرة [59]، لكن جابر من أندر العلماء الذين لم يتركوا قضية نشأتهم إلى الغموض والسر، ودراسة كتبه تبيّن بواسطة احالاته المستمرة إلى مؤلفاته السابقة أن المؤلف يبتدىء بعناصر متواضعة معروفة في عهده.
وهو لم يكن وحيداً، بل كان له اساتذة وزملاء في هذا الميدان، وتبيّن مؤلفاته أنه يشير إلى أفكار القدماء الاجانب مثل: سقراطس، أفلاطون، أرسطوطاليس، هرمس، وكثيرين من المعروفين غيرهم.
لكن الواقع أن هؤلاء العلماء لم يشتغلوا بالكيمياء ؟ حتى أن بعضهم شخصيات خرافية، الأمر الذي أدى بالباحثين إلى الشك في صحة هذه الاحالات، أو الظن بأن المسلمين والعرب احتلقوا كتباً، ونسبوها إلى الاخرين، غير أن هؤلاء الباحثين لم يهتموا بالتساؤل ؟ متى وكيف احتلق المسلمون مثل هذه الكتب ونسبوها إلى الاخرين ؟ [60].
لايعقل أن يتعب شخص في التأليف والتصنيف، ويتعب قريحته وجسده ثم ينسب ما وضعه إلى شخص آخر ؟ وإن ذلك يعد ضرباً من الجهل.
1 – ذكر هولميارد Holmyard
أنه من النادر على أي كيميائي أن ينتج مثل هذه المؤلفات التي تشمل على معرفة كثيرة، واحاطة واسعة لاعمال القدماء، واعتبر جابر من أعظم علماء العصر الوسيط، واهتم بأعماله ومنهجه العلمي ومؤلفاته، فعكف على ابراز القيمة العلمية لعمله وقال:
] إن الصنعة الخاصة عند جابر، هي أنه على الرغم من توجهه نحو التصوف والوهم، فقد عرف واكد على أهمية التجريب بشكل أوضح من كل من سبقه من الخيميائيين [ [61].
ووجد هولميارد أن أن أهمية جابر تتساوى مع أهمية بول ولافوازييه.
2 – بول كراوس Paul Kraus :
هو أول من قام بدراسة أعمال جابر سواء في الكيمياء، أو في فروع أخرى، دراسة جوهرية مسهبة، واهتم بالمظهر الفلسفي عنده،وبرأيه أن بعض مفاهيمه لها معنى اسماعيلي خالص [62]. ووضع كراوس مجلداً ضخماً أسماه (مختار رسائل جابر ).
3 – قال برتلو M. Berthelot عن جابر:
أن لجابر في الكيمياء ما لارسطوطاليس قبله في المنطق [63].
4 – وقال لوبون: G. Lebon
تتالف من كتب جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما وصل اليه علم الكيمياء عند العرب في عصره، وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيميائية كانت مجهوله قبله [64].
ومن جانب آخر، شكّ بعض العلماء بوجود جابر، وذلك لوجود عدد لايستهان به من المخطوطات اللاتينية في الكيمياء منسوبة إلى جابر، حيث قيل أن هذه المخطوطات لاتمت بصلة إلى جابر، وسبب الانتحال أن هذه الكتب الجابرية لاوجود لها في الاصل العربي، وهذا على ما نعتقد لايمنع أن تكون من مصدر عربي، فقد تكون النسخ الاصلية قد فقدت [65].
ويعد روسكا من أكثر المشككين بوجود شخصية جابر ؟ وادعى أن كتبه منتحلة، واستدل بابن خلدون الذي قال بأن جابراً هو من كبار السحرة ؟!! [66].
الخاتمة:
بعد هذا العرض البسيط والموجز جداً عن شخصية جابر بن حيان، وعن أفكاره وكتبه، ينبغي أن نجيب عن تساؤل محتمل قد يدور في ذهن راء والباحثين، وهو:
كيف تمكن جابر من تأسيس مثل هذا العلم ؟؟!
هذا التساؤل شغل أذهان الباحثين وجعلهم يقبلون بافتراض وجود مدرسة للكيمياء تمكنت من القيام بمثل هذا العمل على مدى مائة عام، من أواسط القرن الثالث إلى اواسط القرن الرابع للهجرة [67].
عانى جابر كما عانى الكيميائيون العرب في أول اشتغالهم بهذا العلم من الاضطهاد والمصاعب، وذكر أن جابر خلص من الموت مراراً، كما أنه قاسى من انتهاك الجهلاء لحرمته ومكانته، وأنه اضطر إلى الافضاء ببعض أسرار الطبيعة إلى هارون الرشيد، ويحيى البرمكي وابنيه، وأن ذلك هو السبب في غناهم وثروتهم [68].
وإذا رجعنا إلى رسائل جابر، نجده يذكر معلومات سبقت عصره بقرون، من ذلك تلك الفكرة الهائلة التي أيدتها التجارب اليوم، من ان الجوهر البسيط يشبه العالم الشمسي. بالاضافة إلى ذلك قد يكون الاكسير الذي سعى جابر إلى التوصل اليه، هو اليوم نفسه عنصر (الراديوم)، أو احد الاجسام المشعة، نظراً لنص وضعه البيروني – العالم الاسلامي الكبير في الطبيعة – كما بيّن ذلك إذاعة راديو لندن في 17 نيسان عام 1945، ونشرته مجلة المستمع العربي (سنة 6 عدد 6 )، بعنوان (الراديوم وعلماء العرب )، وجريدة الكيمياء الالمانية في هيدلبرغ – آذار 1958 .
وذكر ذلك في مؤتمر العلوم الدولي الثامن (ذكره مؤلف الكتاب) [69].
وهكذا نرى أن جابراً شخصية فذة، جمعت بين الحكمة والفلسفة والطب والمنطق والتصوف، إلى جانب علم الصنعة، وأن عالماً مثله يؤلف أكثر من 3900 كتاب في علوم جلّها عقلية وفلسفية، لهو حقاً من عجائب الدهر [70].
ولما توفي جابر بالرحبة، قال أبو فراس يرثيه:
بنفسي على جابر حسرة تزول الجبال وليست تزول
له ما بقيت طويل البكاء وحسـن الثناء وهذا قليل [71]
وقيل في جابر أيضاً:
هذا الذي بمقــاله غر الاوائـل والاواخر
ما كنت إلا كاسراً كذب الذي سماك جابر [72]
وأخيراً نقول … مما لاشك فيه، أن جابراً عبقرية علمية بارزة في علم الكيمياء، وكان تأثيره واضحاً وكبيراً في أوربا في القرون الوسطى حتى القرن الثامن عشر، عندما ظهر لافوازييه وغيره.
ولم يقف جابر عند الاراء النظرية فقط كما فعلت الامم القديمة، وإنما دخل المختبر، واجرى التجارب وربط الملاحظات على أسس علمية، وهي الاسس التي بنى عليها العلم الحديث منجزاته في هذا الميدان وفي غيره من الميادين الاخرى [73].
لكن على الرغم من هذه الجهود التي بذلها العلماء العرب، والمواد التي توصلوا إليها، والعمليات التي مارسوها، فإنهم لم يهتدوا إلى القوانين التي تضبط العمليات الفيزيائية، ولم يضعوا للكيمياء قوانين عامة، أو رموزاً تدل عليها، فهذه أمور كانت وليدة الكيمياء الحديثة [74].
المراجع والحواشي
[1] - جابر. بهزاد - الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – بيروت. دار مصباح الفكر 1986 م ، ص61.
[2] - جابر. بهزاد - الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص61.
[3] - نفس المصدر السابق ص61.
[4] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – دار العلم للملايين – بيروت ، 1970 ، ص79.
[5] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الخيمياء – دار الأضواء ، بيروت. الغبيرة ، طبعة 1986 ، ص 435.
[6] - ابن النديم – الفهرست – تعليق الشيخ ابراهيم رمضان ، (دار الفتوى ) بيروت. دار المعرفة ، طبعة أولى 1994 ، ص435.
الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص188.
11 - نفس المصدر السابق ، ص189.
[8] - جابر. بهزاد - الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص62.
[9] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص29.
[10] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص243.
[11] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص30.
[12] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص243.
[13] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص30.
[14] - نفس المصدر السابق ، ص31.
[15] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – المجلد الرابع ، حققه حسن الامين ،
دار التعارف للمطبوعات ، بيروت. 1986 ، ص32.
[16] - نفس المرجع السابق ص32 ، بالاضافة إلى مرجع د. هاشمي ص31.
[17] - الأمين النديم – الفهرست – ص435.، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص31
[18] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص248. بالاضافة إلى كتاب
الفهرست ص435 ، وكتاب أعيان الشيعة للامام السيد محمد الامين ص30.
[19] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص31.
[20] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص261.
[21] - تاتون. رينيه – تاريخ العلوم العام (العلم القديم والوسيط من البدايات حتى سنة
1450م) ، ترجمة د. على مقلد. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،طبعة أولى 1988 ص439.
[22] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص33.
[23] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص263.
[24] - نفس المصدر السابق ، ص263.
[25] - دائرة المعارف الاسلامية. إصدار أئمة من المستشرقين ، النسخة العربية: د. ابراهيم
خورشيد ، أحمد الشنتاوي ، د. عبد الحميد يونس. دار البعث ، المجلد العاشر ،ص205.
[26] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص266.
[27] - نفس المصدر السابق ، ص266.
[28] - نفس المصدر السابق ، ص267.
[29] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص243.
[30] - نفس المصدر السابق ، ص244.
[31] - نفس المصدر السابق ، ص245.
[32] - سيزكين. فؤاد – تاريخ التراث العربي ج4 – ترجمة د. عبدالله حجازي ،
السعودية ، طبعة أولى 1986 ، ص365.
[33] - دائرة المعارف الاسلامية. إصدار أئمة من المستشرقين ، النسخة العربية ، ص202.
[34] - نفس المصدر السابق ، ص204.
[35] - سيزكين. فؤاد – محاضرات في تاريخ العلوم العربية والاسلامية – منشورات العلوم
العربية والاسلامية – سلسلة أ ، مجلد (1) 1984 ، ص62.
[36] - دائرة المعارف الاسلامية. إصدار أئمة من المستشرقين ، النسخة العربية ، ص202.
[37] - نفس المصدر السابق ، ص202 – 203.
[38] - نفس المصدر السابق ، ص203.
[39] - نفس المصدر السابق ، ص203.
[40] - ابن النديم – الفهرست – ص435 ، بالاضافة إلى المرجع: أعيان الشيعة للسيد
محمد الأمين ، ص32.
[41] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص32.
[42] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص198.
[43] - نفس المصدر السابق ، ص199 ، بالاضافة لكتاب: أعيان الشيعة للسيد محمد
الأمين ، ص34.
[44] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص199.
[45] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص267- 268.
[46] - نفس المصدر السابق ، ص266.
[47] - الأمين ، الأمام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص 30.
[48] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص65.
[49] - نفس المصدر السابق ، ص65.
[50] - ابن النديم – الفهرست – ص436.
[51] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص37- 39 بالاضافة إلى كتاب
مختار رسائل جابر لـ كراوس .
[52] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص36.
[53] -نفس المصدر السابق ، ص36.
[54] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص273 ،
بالاضافة لمرجع جابر. بهزاد – الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص68.
[55] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص247.
[56] - نفس المصدر السابق ، ص253.
[57] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص277.
[58] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص251.
[59] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص251.
[60] - نفس المصدر السابق ، ص63.
[61] - نفس المصدر السابق ، ص63.
[62] - نفس المصدر السابق ، ص502.
[63] - الزركلي. خير الدين – الأعلام – ج2 ، ص90 – 91.
[64] - نفس المصدر السابق ، ص91
[65] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص29 –30.
[66] - نفس المصدر السابق ، ص51.
[67] - سيزكين. فؤاد – محاضرات في تاريخ العلوم العربية والاسلامية – ص63.
[68] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص31.
[69] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص198.
[70] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص30
[71] - نفس المصدر السابق ، ص30
[72] - نفس المصدر السابق ، ص36.
[73] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص268.
[74] - جابر. بهزاد – الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص 67.
وشكرا
مع تحياتي
ملك البلاد
وشكرا
اي بحث ودكم اليه اكتب اسمه ولا يهمكم ان شاء الله اجيبه لكم
[line]
ستجدون هنا حتى الآن العناوين الآتية :
*جابر بن حيان
*طه حسين
*التنفس ( التنفس الاصطناعي – امراض التنفس – الجهاز التنفسي
*الجغرافيا البشرية
*خليل مطران
*علم الجغرافيا
*الآثار العمانية
*الإيدز
*عمر بن الخطاب
*علم البلاغة
*المتنبي
*مصعب بن عمير
*التربية الجمالية في الإسلام
*الحجاج بن يوسف الثقفي
*سعيد بن جبير
*علم الجغرافيا
*الضغط ( فيزياء )
*أحمد شوقي
*الاستنساخ
*عمان في العصر العباسي
*علم الفيزياء
*علم الكيمياء
جابر بن حيان
ولد جابر بن حيان في طوس سنة 120 هــ -737م ، وتوفي سنة 198هــ _813م
اشتهر جابر بن الحيان بالعلوم ولا سيما الكيمياء ، له في الكيمياء والمنطق والفلسفة الكثير من المؤلفات والمصنفات المشهورة والتي ضاع معظمها ولم يبق منها غير ثمانين كتابا ورسالة . وفي المكتبات العامة والخاصة سواء في الشرق والغرب ،وقد تم ترجمة بعض المؤلفات إلى اللغة اللاتينية وكان ذلك له الأثر الكبير
في تكوين مدرسة كيميائية في الغرب ذات اثر فعال.
ولقد اعتراف الغرب بفضل جابر فقال (ليكارل) في كتابه تاريخ الطب العربي : إن جابر من اكبر العلماء في القرون الوسطى وأعظم علماء عصره وكذلك يعترف (سارطون ) بفضل جابر ويقول انه كان شخصية فذة ومن أعظم الذين برزوا في ميدان العلم في القرون الوسطى ، وكان جابر شديد الشغف بالكيمياء فقد درسها دراسة وافية ووقف على ما انتجة السبابقون . وقد جعل الكيمياء تقوم على تجربة والملاحظة والاستنتاج ، كل هذه العوامل جعلت اسم جابر بن الحيان من الخالدين في التاريخ الكيميائي .
ولقد عدل جابر في نظرية (أرسطو) التي تتحدث عن تكوين الفلزات وجعلها أكثر ملاءمة للحقائق العلمية المعروفة وكتاب ذلك في كتابه الإيضاح وخارج بذلك بنظرية جديدة عن تكوين الفلزات .
وابتكر جابر علم الوازين في الكيمياء ، وأول من استحضر حــامض الكبريتيك بتقطيره من الشبة وسماه (زيت الزاج) وكان لجابر بن الحيان الأثر الكبير في الكيمياء والطاقة .
وقد استحضر أيضا حامض النيتريك ، وأول من كشف الصودا الكاوية وأول من استحضر ماء الذهب وأول من فصل الذهب عن الفضة بواسطة الحامض .
وهو أول من لاحظ ما يحضر من راسب (كلوريد الفضة) وكذلك ينسب اليه تحضير المركبات مثل كوبونات البوتاسيوم وكوبونات الصوديوم ، وكذلك درس خصائص المركبات الزئبقية وتحضيره .
وله كتاب عن السموم (كتاب السموم ودفع مضارها) وقد ذكر فيه وأسرار وأقوال الفلاسفة اليونان في السموم ،
كما تضمن الكتاب تقسيمات لأنواع السموم وينقسم الكتاب الى فصول:
الاول : يذكر فيه اوضاع القوى الاربع وحالتها مع الادوية المسهله والسموم القاتلة .
الفصل الثاني : في اسماء السموم ومعرفة الجيد منها والردئ .
الفصل الثالث :في ذكر السموم العامه الفعل في سائر الابدان .
الفصل الرابع : في علامات السموم المسقاة والحوادث العارضة .
الفصل الخامس : في ذكر السموم المركبة .
الفصل السادس : في الاحتراس من السموم قبل اخذها وذكر الادوية النافعة من السموم .
وبعد ان بين جابر بن الحيان انواع السموم ، فقد قسمها الى حيوانية ونباتية وحجرية ، وذكر في السموم الحيوانية مرارة الافـاعي ومراره النمر ولسان السحلفاة والضفدع والعقارب .
ومن السموم النباتية قرون السنبل والافيون والشليم والحنضل والشكوران .
ومن السموم الحجرية الزئبق والزرنيخ والزاج وبرادة الحديد والطلق وبرادة الذهب .
وقد دعا جابر الى الاهتمام بالتجربة ، وحث على اجرائها مع دقة الملاحظة ، وقد قال : ان واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل واجراء التجربة , وان المعرفة لا تحصل الا بها .
وقد وفق جابر بن الحيان في عمليته الكيميائية كالتبخير والتقطير والتكليس والاذابة والتبلور .
ومن كتب جابر بن الحيان كتاب الجمع وكتاب الاستتمام وكتاب الاستيفاء وكتاب التكليس .
وكان ذالك سببأ في اعتراف علماء اوروبا بفضل جابر بن الحيان فى هذا المجال ولقد قال عنه (برتيلو):
"لجابر بن حيان في الكيمياء ما لاسطو طاليس في ....." .
[line]
جابر بن حيان وعلم الكيمياء (علم الصنعة)
ملخص البحث
هذا البحث المبسط والموجز يكشف عن صفحة مشرقة من صفحات تراثنا العلمي العربي، ويبيّن ما للعرب من أصالة في التراث العلمي والإنساني الذي استقى منه التراث العالمي فترة طويلة من الزمن. فإذا تجاوزنا العلوم التي أبدع فيها العرب إلى علم الكيمياء الذي يهمنا في هذا البحث، نرى أن العرب قد ابتكروا كثيراً في حقل الكيمياء معتمدين على البحث التجريبي الذي يعدون فيه رواداً نحو الحقيقة وعلى رأس هؤلاء الرواد العالم العربي المتصوف جابر بن حيان الذي تضاربت الآراء والأقوال حول وجوده وحقيقته. فكأنما الإنسانية تستكثر على نفسها أن يظهر من أبنائها واحداً يتجاوز بنبوغه حداً معقولاً. وتشكل مجموعة الكتب الكثيرة التي تحمل اسم جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما توصل إليه الكيميائيون العرب حتى عصره، وتنم عن اطلاعه الواسع وتجاربه العلمية، وأهم هذه الكتب: نهاية الإتقان، الميزان، السموم، وكتب أخرى كثيرة، وآخرها كان كتاب الرحمة الذي وجد تحت رأسه عندما مات.
من جملة ما اهتم به جابر (واهتم به الأسبقون وكان غاية الحكماء) هو إمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب (علم الكيمياء أو علم الصنعة)، بالإضافة إلى الحصول على حجر الحكماء أو حجر الفلاسفة أو ما يدعى بالإكسير، وهذا ما سيتناوله هذا البحث الموجز.
مقدمة:
اختلف مؤرخو العلم حول أصل كلمة كيمياء. فمنهم من ردها إلى الفعل اليوناني chio الذي يفيد السبك والصهر، ومنهم من أعادها إلى كلمتي chem , kmt المصريتين ومعناهما الارض السوداء، ومنهم من يرى أنها مشتقة من كلمة كمى العربية أي ستر وخفى ].
ويعرّف ابن خلدون الكيمياء بأنها (علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة)، ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك
لقد تأثرت الكيمياء العربية بالكيمياء اليونانية والسريانية وخاصة بكتب دوسيوس و بلنياس الطولوني الذي وضع كتاب (سر الخليقة). غير أن علوم اليونان والسريان في هذا المجال لم تكن ذات قيمة لأنهم اكتفوا بالفرضيات والتحليلات الفكرية.
وتلجأ الكيمياء إلى الرؤية الوجدانية في تعليل الظواهر، وتستخدم فكرة الخوارق في التفسير، وترتبط بالسحر وبما يسمى بعلم الصنعة، وتسعى إلى تحقيق هدفين هما:
أ – تحويل المعادن الخسيسة كالحديد والنحاس والرصاص إلى معادن شريفة كالذهب والفضة عن طريق التوصل إلى حجر الفلاسفة.
ب – تحضير أكسير الحياة، وهو دواء يراد منه علاج كل ما يصيب الإنسان من آفات وأمراض، ويعمل على إطالة الحياة والخلود.
وهذان الهدفان سـنناقشـهم في هذا البحث من وجهة نظر وعمل أبي الكيمياء العالم العربي جابر بن حيان.
تطور علم الكيمياء عند القدماء:
إن تاريخ الكيمياء في العالم القديم أكثر غموضاً من تاريخ الفيزياء، ونحن لا نعلم من تاريخ الكيمياء إلا النتائج العملية، ولم يدوّن لنا القدماء من ذلك التاريخ شيئاً
يمكن اعتبار الكيمياء الصينية أقدم المعارف الكيميائية، لكن لايزال السؤال غامضاً عن صلة الوصل بين الكيمياء الصينية والكيمياء المصرية القديمة، وهذا ما حاول الباحث جونسون Jhonson أن يبرهن عليه، حيث ذكر عن كاتب صيني قديم يرجع عهده إلى سنة 330 ق. م أنه حرّر عن الفلسفة التاتوئية والسيمياء، والأخيرة تحتوي على كيفية تحويل المعادن إلى معادن ثمينة، وكيفية الحصول على إكسير الحياة، تلك المادة التي تطيل الحياة على زعمهم وتقضي على الموت .
وقد قال ابن النديم أنه زعم أهل صناعة الكيمياء، وهي صناعة الذهب والفضة من غير معادنها، أن أول من تكلم عن علم الصنعة هو هرمس الحكيم البابلي المنتقل إلى مصر عند افتراق الناس عن بابل، وإن الصنعة صحّت له، وله في ذلك عدة كتب، وإنه نظر في خواص الأشياء وروحانيتها.
وزعم الرازي أن جماعة من الفلاسفة عملوا في الكيمياء مثل: فيثاغورس، ديموقراط، أرسطاليس، جالينوس، وغيرهم، ولايجوز أن يسمى الإنسان فيلسوفاً إلا أن يصح له علم بالكيمياء.
وقال آخرون أن علم الكيمياء (قديماً) كان بوحي من الله عز وجل إلى موسى بن عمران (قصة قارون).
الكيمياء في القرون الوسطى:
أشهر شخصية من شخصيات الكيمياء الغربية في القرون الوسطى وخاصة التي تناولت فكرة الحصول على الذهب هو العالم برنارد تريفيزان Bernard Trevisan حيث رافقت هذا المغامر في الكيمياء فكرة البحث عن الذهب في الصخور والأحجار والمعادن والاملاح وغير ذلك.
سافر إلى بلاد الإغريق والتتار والقسطنطينية وزار مصر، لكنه لم يمس تبرها.
خامرت العالم برنارد فكرة الحصول على الذهب من الإنسان لأنه تاج الخليقة، ويشكل الذهب ذروة الكمال المعدني، وأراد أن يحل مشكلته الكبرى في أشعة الشمس للاعتقاد السائد قديماً بأن هذه الأشعة هي التي تكون المعادن، وما الذهب إلا أشعة الشمس المتكاثفة التي استحالت إلى جسم أصفر براق.
واعتقد بنمو المعادن، حتى أن أصحاب المناجم كانوا يغلقون مناجمهم برهة من الزمن ليعطوا المعادن فرصة التكون. وقد بدد ثروته الهائلة على تلك الافكار .
علم الكيمياء عند العرب المسلمين:
بدأت الكيمياء في الإسلام بالصنعة، ذلك لأن العرب اعتمدوا الكتب المنقولة عن اليونانية، وكتب الإسكندرانيين التي نقلت إلى العربية. ويعتبر خالد بن يزيد بن معاوية أول من اشتغل في علم الصنعة عند العرب، حيث استقدم بعض الرهبان الأقباط المتفحصين بالعربية، كمريانوس، شمعون، وغيرهم، وطلب إليهم نقل علوم الصنعة إلى اللغة العربية عله يتمكن من تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب.
وهكذا وصلت الصنعة إلى العرب بواسطة الإسكندرانيين ممتزجة بالأوهام والأضاليل، تهدف إلى تحقيق غايات وهمية تتعلق بالصحة والخلود والثروة بعيدة عن الكيمياء التي ترتكز على قواعد وقوانين علمية.
وقد انتقل هذا المفهوم إلى العلماء العرب فاعتقدوا كاليونان والسريان أن طبائع العناصر قابلة للتحويل، وأن جميع المعادن مؤلفة من عناصر واحدة هي الماء، الهواء، التراب، النار، وسبب اختلافها فيما بينها يعود إلى اختلاف نسب هذه العناصر في تركيبها، فلذلك لو توصلنا إلى حلّ أي معدن إلى عناصره الأساسية، وأعدنا تركيبه من جديد بنسب ملائمة لنسب أي معدن آخر كالذهب والفضة مثلاً، لاستطعنا الحصول على هذا المعدن.
من أجل ذلك قام العلماء العرب بتجارب عديدة، أحاطوها بالسرية التامة، واستعملوا الرموز في الإشارة إلى المعادن فأشاروا إلى الذهب بالشمس، والى الفضة بالقمر، فاكتشفوا مواد جديدة، واختبروا أموراً مختلفة، وتوصلوا إلى قوانين عديدة، واستطاعوا أن ينقلوا الخيمياء إلى الكيمياء وذلك لعدة أسباب منها:
1- فشل محاولات الصنعة في تحقيق أهدافها، وتحولها إلى علم تجريبي على يد العالم جابر بن حيان ومن ثم الرازي.
2- تكثيف التجارب المادية والتماس منهج علمي صحيح قائم على التجربة والبرهان.
ومع جابر بن حيان انتقلت الكيمياء عن العرب من طور صنعة الذهب الخرافية إلى طور العلم التجريبي في المختبرات.
جابر بن حيان:
ترتبط نشأة الكيمياء عند العرب بشخصية أسطورية أحياناً وتاريخية حيناً آخر، هي شخصية جابر بن حيان، ونستنتج من خلال الكتب التي تحمل اسمه أنه من أشهر الكيميائيين العرب، ويعدّ الممثل الأول للكيمياء العربية.
وقد أثّر جابر في الكيمياء الأوربية لظهور عدد لا يستهان به من المخطوطات اللاتينية في الكيمياء منسوبة إلى جابر بن حيان .
مولده – نشأته:
هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي المعروف بالصوفي. ولد في طوس (خراسان ) وسكن الكوفة، حيث كان يعمل صيدلانياً. وكان أبوه عطاراً. بنسبته الطوسي أو الطرطوسي، وينحدر من قبيلة الازد.
يقال إنه كان من الصابئة، ومن ثم لقبه الحرّاني، كان من أنصار آل البيت (بعد أن دخل الإسلام وأظهر غيرة عظيمة على دينه الجديد )، ومن غير الموالين للدولة العباسية في بداية حياته .
كان يعيش في ستر وعزلة عن الناس فقيل عنه إنه كان صوفياً.
ويقدّر الزمن الذي ولد فيه جابر بين 721 م – 722 م، أما تاريخ وفاته فغير معروف تماما. ويقال أنه توفي سنة 200 هـ أو ما يوافق 815 م .
ويقول هولميارد Holmyard أن جابر عاش ما يقارب 95 سنة، ودليله في ذلك أن المؤلفات التي ألّفها لا يمكن إنجازها بأقل من هذا الزمن.
رحل إلى الجزيرة العربية وأتقن العربية وتعلّم القرآن والحساب وعلوماً أخرى على يد رجل عرف باسم (حربي الحميري) وقد يكون هو الراهب الذي ذكره في مصنفاته وتلقّن عنه بعض التجارب.
اتصل بالإمام جعفر الصادق (الإمام الخامس بعد علي بن أبي طالب ) ت 148 هـ، ويقال إنه أخذ علم الصنعة عنه، وتتلمذ على يديه، وعن طريقه دخل بلاط هارون الرشيد بحفاوة.
اختلاف الرواة والمفكرين في أمره ووجوده:
اختلف الرواة في أمر جابر، فقد أنكر قوم أن يكون قد مرّ في هذه الحياة رجل يحمل هذا الاسم، وقال آخرون إنه رجل معروف في التاريخ، وقد اشتغل بصناعة الكيمياء، واستطاع أن يحوّل المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة.
وزعم قوم من الفلاسفة أنه منهم، وله كتب في المنطق والفلسفة. وزعم آخرون ( أهل صناعة الذهب والفضة) أن الرئاسة انتهت إليه في عصره وأن أمره كان مكتوماً.
لكن جابر بن حيان حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، وعلم من أعلام العرب العباقرة، وأول رائد للكيمياء، وقد أيّد هذه الحقيقة أبو بكر الرازي، عندما كان يشير إلى جابر في كتبه فيقول "أستاذنا.
مدرسته:
أخذ جابر مادته الكيمياء من مدرسة الإسكندرية التي كانت تؤمن بانقلاب العناصر، وقد كان تطورها من النظريات إلى العمليات. وقد درس جابر ما خلّفه الأقدمون، فلم يرَ من تراثهم من الناحية الكيميائية إلا نظرية أرسطو عن تكوين الفلزات، وهي نظرية متفرعة عن نظريته الأساسية في العناصر الأربعة: الماء، الهواء، التراب، النار.
ولم يعرف فقط كبار مفكري وعلماء العالم اليوناني، بل كان يعرف الكتب ذات المحتوى السري جداً مثل كتب أبولينوس التيتاني. وزعم هولميارد أن المصدر الذي استقى منه جابر علومه في الكيمياء هو الأفلاطونية الحديثة.
منهجه العلمي:
العلم عند جابر يسبق العمل، فليس لأحد أن يعمل ويجرب دون أن يعلم أصول الصنعة ومجالات العلم بصورة كاملة وقد قال: "إن كل صنعة لابد لها من سبوق العلم في طلبها للعمل".
وقطع جابر كأحد رواد علماء العرب خطوة أبعد مما قطع اليونان في وضع التجربة أساس العمل لا اعتماداً على التأمل الساكن، ولعله أسبق عالم عربي في هذا المضمار، فنراه يقول:
] وملاك هذه الصنعة العمل، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبداً [.
وقد كان جابر انطلاقاً من قناعته بامكانية قيام العلم الطبيعي على قاعدة الاتقان المتين، كان شجاعاً بما فيه الكفاية، فهو يؤمن بأنه انتزع من الطبيعة آخر خفاياها، سمة علمه أنه لا يعترف بوجود أي حد للتفكير البشري.
تساءل جابر ؟! ألا يمكن أن يكون التوليد ممكناً، ] فالكائن الحي بالنسبة له بل الانسان نفسه، إنما هو نتيجة تفاعل قوى الطبيعة، فمن الممكن من الناحية النظرية على الأقل- محاكاة تدبير الطبيعة بل تحسينه عند الحاجة [.
ومهما يكن من أمر، فإن قيام جابر كعالم كيميائي ابتكر المنهج التجريبي في الكيمياء، لايعني أن هذا العالم قد تخلص من الافكار القديمة، وحرّر فكره ومذهبه منها، إذ أن له بعض الكتابات الغريبة والطلسمات، لكن هذا لايعني أيضاً أنه لم يشق طريقه في الظلمات عبر العصور المظلمة إلى النور.
ولجابر الكبير في تطور الكيمياء وانتقالها من صنعة الذهب الخرافية إلى طور العلم التجريبي في المختبرات، حيث أن موضوع الحصول على الذهب لم يشغله عن غيره من النواحي العلمية الاخرى، فشمل نشاطه المسائل النظرية والعلمية العادية وغير العادية.
فقد عرف جابر الكثير من العمليات العلمية كالتقطير، التبخير، التكليس، الإذابة، التبلور، وغيرها [27].
كما شمل عمله الناحية التطبيقية للكيمياء، من ذلك أنه أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض، وهذه طريقة لا زالت مستخدمة حتى الان، ولها شأن في تقدير عيارات الذهب في المشغولات والسبائك الذهبية [28].
رأي جابر في طبائع العناصر، وإمكانية تحويلها إلى ذهب:
ينطلق جابر في الصنعة من أن لكل عنصر روحاً (نفساً، جوهراً ) كما نجد في أفراد الناس والحيوان، وأن للعناصر طبائع، وهذه الطبائع في العناصر قابلة للتبدل.
ويرى جابر أن العنصر كلما كان أقل صفاءً (ممزوجاً بعناصر اخرى ) كان أضعف تأثيراً، فإذا أردنا عنصراً قوي الاثر (في غيره)، وجب تصفيته، والتصفية تكون بالتقطير، فبالتقطير تصعد الروح من العنصر فيموت العنصر. يقول جابر:
] فإذا استطعنا أن نسيطر على روح هذا العنصر، ثم القينا شيئاً منه ( الروح وهي مذكر) على مادة ما، انقلبت تلك المادة فكانت مثل العنصر الذي القينا فيه شيئاً من روحه [ [29].
تطبيق هذا الرأي على الذهب:
يقول جابر:
] إن أصفى العناصر الحاضرة الذهب، لكن صفاءه غير تام، فيجب أن نصفّيه مرة بعد أخرى، حتى نبلغ به درجة الصفاء المطلقة، ونستخرج روحه في ايدينا إكسيراً أو دواءً، يعمل في المعادن عمل الخميرة في العجين [.
فكما أن الخميرة تجعل العجين الفطير كله عجيناً مختمراً، فكذلك الاكسير (الاحمر المستخرج من الذهب ) يقلب المعادن ذهباً، والاكسير (الابيض المستخرج من الفضة) يقلب المعادن فضة.
أما العناصر التي تقبل عند أصحاب الصنعة الانقلاب ذهباً وفضة (بسهولة ) فهي النحاس والزئبق والرصاص والحديد [30].
ويبدو أن (الروح، الخميرة، الاكسير، حجر الفلاسفة، الكيمياء ) اسماء مختلفة لشيء واحد.
فالاكسير برأي جابر يمكن الحصول عليه بغلي الذهب في سوائل مختلفة مرة بعد مرة ألف مرة، ولا شك في أن هذا الزعم باطل [31].
ولجابر رأي روحاني متطرف في طبائع المعادن (ذكر ذلك في كتاب الرحمة)، فهو يعد المعدن كائناً حياً ينمو في باطن الارض أمداً طويلاً آلاف السنين، وينقلب من معدن خسيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب، وغاية علم الكيمياء الاسراع بهذا الاقلاب، وهو يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل والتعليم على المعدن، وكذلك مذاهب الحياة والموت [32].
كان جابر يرى أن المعادن تحت تأثير الكواكب، تتكون في الارض من اتحاد الكبريت الحار واليابس مع الزئبق البارد والرطب.
ويرجع وجود المعادن بأنواع مختلفة إلى أن الكبريت والزئبق ليسا نقيين على الدوام، ولأنهماً فضلاً عن ذلك لايتحدان بالنسب ذاتها، فإذا كانا نقيين تماماً، وحصل الاتحاد كاملاً بالميزان الطبيعي، نشأ الذهب أكمل المعادن [33].
أما الاخلاط والنسب غير الكاملة فتؤدي إلى تكوين الفضة أو الاسرب أو الحديد أو النحاس. ولما كان لهذه المعادن في الاصل التركيب ذاته الذي للذهب، فيمكن تصحيح (تأثير) المصادفات في طريقة تركيبها بتدبير مناسب، وهذا التدبير يُشكّل غرض الصنعة، ويعول على استعمال الاكاسير [34].
ومن هنا نستنتج أن جابراً يرى أنه من غير المستحيل تكوين الذهب نظرياً على الاقل، وإن كان ذلك صعباً تجريبياً ! [35].
تدبير جابر للأكاسير:
من أهم جوانب علم الكيمياء عند جابر، استناده على الاكسير العضوي، بالاضافة إلى الإكسير غير العضوي.
فمن العلامات المميزة في الصنعة عند جابر تدبير الأكاسير لا على أساس معدني فحسب، بل كذلك على اساس مواد حيوانية ونباتية، بل إنه يفضل الاكسير الذي يرجع إلى مواد حيوانية، لما لهذه المواد من فعل أقوى بكثير مما للاكاسير الاخرى.
يرى جابر أنه يمكن عمل اكاسير مختلطة بهذه المواد المذكورة، من ذلك مثلاً إكسير نباتي – حيواني، إكسير نباتي - معدني، إكسير حيواني – معدني، إكسير نباتي - حيواني – معدني.
ولايمكن بلوغ هذه الاكاسير المختلفة، وكذا الاكسير الاعظم، أي العقار العام لكل المعادن [36].
ولا بد للحصول على الاكسير الصحيح من الرجوع إلى اصول أكيدة، واستيفاء كل أسباب الدقة.
وقد اعتمد جابر في ذلك على فكرة أن كل الاشياء في العالم الطبيعي تتركب من عناصر اربعة، تشكلت بدورها من أربع كيفيات.
ومن الممكن عن طريق (الميزان) معرفة نصيب الطبائع الاربع في كل جسم، وبالتالي تجديد تركيبه بدقة تامة.
وبهذه الطريقة يمكن للكيميائي أن يتحكم في كل التغيرات التي تحصل في الجسم، ما دام في وضع يدبر فيه كلاً على حدة الاصول والكيفيات التي تعمل بها الطبيعة، كما يصبح في وضع يمكنه من تدبير أجسام جديدة، وبخاصة اكاسير مختلفة تفعل في المعادن [37].
وما الصور المختلفة للاكاسير إلا مزائج تجانست قليلاً أو كثيراً، مع الطبائع أو الخواص الاربع، مزائج تتفق مع تركيب الاجسام التي استعملت عليها.
وها هو ذا تحديد عمل الاكسير كما بيّنه جابر نفسه في كتاب السبعين:
إن الاصول الاربعة العاملة في الاجسام من الاجناس الثلاثة المؤثرة فيها والمحددة لصبغها هي: النار، الماء، الهواء، الارض.
وفي الواقع ليس هناك فعل واحد من هذه الثلاثة أجناس إلا بتلك العناصر الاربعة. ولهذا، كان معولنا في هذه الصناعة على تدبير هذه العناصر، نقوّي ضعيفها، ونضعّف قويها، ونصلح فاسدها. فمن وصل إلى عمل هذه العناصر الاربعة في هذه الثلاثة أجناس، فقد وصل إلى كل علم، وادرك علم الخليقة وصنعة الطبيعة [38].
يقول جابر في كتابه السبعين على سبيل المثال:
إن الاسرب بارد يابس في الظاهر، وحار رطب في الباطن، وكذلك بالنسبة للفضة، بينما الذهب حار رطب في الظاهر، وبارد يابس في الباطن [39].
ويقال أن جابراً كان أكثر مقامة في الكوفة، وبها كان يدبر الاكسير لصحة هوائها [40].
وذكر جابر في كتابه (الخواص الكبير)، قصة اتصاله بيحيى البرمكي، وعمل اكسيره، وكيف خلصّ به كثيراً من الناس وشفاهم !.
تطلعنا قصته هذه، على أن جابراً كان طبيباً، وكان يستخدم في العلاج دواء يسميه الاكسير، يبدو أنه كان يشفي كثيراً من العلل [41].
أما ما له علاقة بالاكسير من جهة المسؤولية الكبرى، واكتشاف سر الله الاعظم، فله علاقة بالامام جعفر علاقة شديدة [42].
فجابر يعتقد بوجود طريقتين لادراك الصنعة:
أ – طريق ظاهري: وذلك باقتفاء أثر الطبيعة.
ب – طريق باطني : بمعرفة الفرضيات الكبرى، وتطهير النفس البشرية.
والثاني يشير إلى تصوفه وتشيعه الواضحين
[43]. إذ أن أهم مصادر معرفته، الالهامات الباطنية التي اقتبسها عن إمامه جعفر الصادق، فعلاقته مع الامام جعفر الصادق هي علاقة فكرية فلسفية.
والعلاقة بين جابر وإمامه الصادق لا تقف عد حد واحد، إنما تتعداه إلى أمر كشف سر الله الاعظم ألا وهو الاكسير ؟! [44].
] ولن أشير أكثر إلى العلاقة بين العالم جابر بن حيان وإمامه جعفر الصادق لسعة البحث في هذا الامر، ولاختصار دراستنا على جانب علمي معين في علم العالم الكيميائي جابر بن حيان [.
اكتشافات جابر الكيميائية الاخرى:
سنذكر بعضاً منها:
1- عرف جابر بأن الشب يساعد على تثبيت الاصباغ في الاقمشة، والعلم الحديث اثبت ذلك، (الشب = أملاح الالمنيوم).
2- توصل جابر إلى تحضير بعض المواد التي تمنع البلل عن الثياب، وهذه المواد هي أملاح الالمنيوم المشتقة من الحموض العضوية.
3- توصل إلى استخدام كبريتيد الانتموان، الذي له لون الذهب، ليعوّض عن الاخير الغالي الثمن.
4- تمكن من صنع ورق غير قابل للاحتراق، والعلم الحديث لايعرف حتى الان نوع هذا الورق [45].
5- أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض (الماء الملكي) وهذه الطريقة لازالت مستخدمة حتى الان.
6- مارس كثيراً من العمليات الكيميائية، كالتقطير، التكليس، التبلور، التصعيد، وعرف واكتشف الكثير من المواد الكيميائية [46].
لمحة عن كتبه:
ألفّ جابر عدداً كبيراً جداً من الكتب، يقال أنها تجاوزت – 3900 كتاب – [47]، كانت سبباً في الشك بوجوده، أو حتى نسبها جميعاً إليه.
له كتب في الكيمياء، الفلسفة، التنجيم، الرياضيات، الموسيقى، الطب والسحر ورسائل دينية اخرى.
تميّزت مخطوطاته وكتبه بوحدتها، مما يدل على أنها تابعة لمدرسة واحدة، والكتب التي تغلب عليها نزعة الكيمياء هي كتب السبعين والرحمة، أما الكتب التي تغلب عليها النـزعة الطبية فهي رسائل السموم [48].
ولجابر أسلوب لايشبه أسلوب باقي المؤلفين، فأسلوبه يتميز بالجدية، والفكرة الواحدة والتفكير العميق [49].
وقد ذكر ابن النديم ما يزيد عن 360 مؤلفاً لجابر، يمكن الرجوع اليها في كتاب الفهرست [50]، وكذلك ذكرها كرواس في مؤلفه رسائل جابر [51].
يمكن أن نعدّ رسائل جابر في الكيمياء أول مظهر من مظاهر الكيمياء في المدنية الاسلامية، على الرغم من أن عدداً عظمياً من رسائله كان نصيبها الفناء، بينما بقيت بعض الكتب اللاتينية التي أُخذت عنها.
تلاميذه:
قال ابن النديم: أسماء تلامذته (الخرقي ) الذي ينسب اليه سكة الخرقي بالمدينة، (وابن عياض المصري )، و(الاخميمي) [52].
ويقول الرازي في كتبه المؤلفة في الصنعة:
] قال استاذنا أبو موسى جابر بن حيان [، ومراده بقوله استاذنا، أنه استفاد من مؤلفاته، لا أنه تعلم منه، لأن عصر الرازي متأخر عنه كما هو معلوم [53].
مشاهير العلماء الآخرين في الكيمياء:
ورأيهم في مسألة تحويل المعادن الخسيسة إلى ثمينة ؟
أ - الكندي: ت 252 هـ / 866م
يعتبر الكندي أول من اتحذ موقفاً سلبياً من مسألة تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب أو فضة، وقال باستحالة ذلك، ووضع رسالة في (بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخداعهم ) [54].
ب – الرازي: ت 321 هـ / 942 م
برع في الكيمياء كما برع في الطب، ووضع الرازي كتباً عديدة في الكيمياء، ويبدو فيها غير مقتنع بتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة تارة، وتارة أخرى تظهر الكتب اقتناعه بذلك، منها كتاب محنة الذهب والفضة، وكتاب الاسرار [55].
جـ – ابن سينا: ت 428 هـ / 1037 م
لم يضع أي مؤلف بهذا الشأن، له كتاب في بطلان الكيمياء والرد على اصحابها [56].
في مستهل القرن الحادي عشر الميلادي، مرّ على الكيمياء فترة من الجمود استمرات حوالي القرنين حتى أتى عالم من العراق اسمه السماوي.
د – محمد بن أحمد العراقي السماوي:
أشهر مؤلفاته كتاب المكتسب في زراعة الذهب، ودافع فيه عن امكانية تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، واعتمد في طريقته على وصف الاكسير على العالم جابر بن حيان ومن شايعه [57].
هـ – اخوان الصفا: قرن رابع هجري / عاشر ميلادي
اعتقد اخوان الصفا، أن بعض المعادن يستحيل إلى بعض، لكن في باطن الارض، في أزمان طويلة مختلفة الطول، لا على يد الانسان في وقت قصير. ولم يتكلموا عن قلب المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة [58].
رأي العلماء والمفكرين في جابر بن حيان:
كيف تمكن جابر من تأسيس مثل هذا العلم الواسع ؟؟
سؤال دار في الاذهان، وشغل عقول بعض الباحثين والمفكرين، وجعل البعض ينفي وجود مثل هذا الشخص بينما قبل البعض الآخر فيه، بافتراض وجود مدرسة للكيمياء، تمكنت من القيام بهذا العمل على مدى مئة عام من أواسط القرن الثالث إلى أواسط القرن الرابع للهجرة [59]، لكن جابر من أندر العلماء الذين لم يتركوا قضية نشأتهم إلى الغموض والسر، ودراسة كتبه تبيّن بواسطة احالاته المستمرة إلى مؤلفاته السابقة أن المؤلف يبتدىء بعناصر متواضعة معروفة في عهده.
وهو لم يكن وحيداً، بل كان له اساتذة وزملاء في هذا الميدان، وتبيّن مؤلفاته أنه يشير إلى أفكار القدماء الاجانب مثل: سقراطس، أفلاطون، أرسطوطاليس، هرمس، وكثيرين من المعروفين غيرهم.
لكن الواقع أن هؤلاء العلماء لم يشتغلوا بالكيمياء ؟ حتى أن بعضهم شخصيات خرافية، الأمر الذي أدى بالباحثين إلى الشك في صحة هذه الاحالات، أو الظن بأن المسلمين والعرب احتلقوا كتباً، ونسبوها إلى الاخرين، غير أن هؤلاء الباحثين لم يهتموا بالتساؤل ؟ متى وكيف احتلق المسلمون مثل هذه الكتب ونسبوها إلى الاخرين ؟ [60].
لايعقل أن يتعب شخص في التأليف والتصنيف، ويتعب قريحته وجسده ثم ينسب ما وضعه إلى شخص آخر ؟ وإن ذلك يعد ضرباً من الجهل.
1 – ذكر هولميارد Holmyard
أنه من النادر على أي كيميائي أن ينتج مثل هذه المؤلفات التي تشمل على معرفة كثيرة، واحاطة واسعة لاعمال القدماء، واعتبر جابر من أعظم علماء العصر الوسيط، واهتم بأعماله ومنهجه العلمي ومؤلفاته، فعكف على ابراز القيمة العلمية لعمله وقال:
] إن الصنعة الخاصة عند جابر، هي أنه على الرغم من توجهه نحو التصوف والوهم، فقد عرف واكد على أهمية التجريب بشكل أوضح من كل من سبقه من الخيميائيين [ [61].
ووجد هولميارد أن أن أهمية جابر تتساوى مع أهمية بول ولافوازييه.
2 – بول كراوس Paul Kraus :
هو أول من قام بدراسة أعمال جابر سواء في الكيمياء، أو في فروع أخرى، دراسة جوهرية مسهبة، واهتم بالمظهر الفلسفي عنده،وبرأيه أن بعض مفاهيمه لها معنى اسماعيلي خالص [62]. ووضع كراوس مجلداً ضخماً أسماه (مختار رسائل جابر ).
3 – قال برتلو M. Berthelot عن جابر:
أن لجابر في الكيمياء ما لارسطوطاليس قبله في المنطق [63].
4 – وقال لوبون: G. Lebon
تتالف من كتب جابر موسوعة علمية تحتوي على خلاصة ما وصل اليه علم الكيمياء عند العرب في عصره، وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيميائية كانت مجهوله قبله [64].
ومن جانب آخر، شكّ بعض العلماء بوجود جابر، وذلك لوجود عدد لايستهان به من المخطوطات اللاتينية في الكيمياء منسوبة إلى جابر، حيث قيل أن هذه المخطوطات لاتمت بصلة إلى جابر، وسبب الانتحال أن هذه الكتب الجابرية لاوجود لها في الاصل العربي، وهذا على ما نعتقد لايمنع أن تكون من مصدر عربي، فقد تكون النسخ الاصلية قد فقدت [65].
ويعد روسكا من أكثر المشككين بوجود شخصية جابر ؟ وادعى أن كتبه منتحلة، واستدل بابن خلدون الذي قال بأن جابراً هو من كبار السحرة ؟!! [66].
الخاتمة:
بعد هذا العرض البسيط والموجز جداً عن شخصية جابر بن حيان، وعن أفكاره وكتبه، ينبغي أن نجيب عن تساؤل محتمل قد يدور في ذهن راء والباحثين، وهو:
كيف تمكن جابر من تأسيس مثل هذا العلم ؟؟!
هذا التساؤل شغل أذهان الباحثين وجعلهم يقبلون بافتراض وجود مدرسة للكيمياء تمكنت من القيام بمثل هذا العمل على مدى مائة عام، من أواسط القرن الثالث إلى اواسط القرن الرابع للهجرة [67].
عانى جابر كما عانى الكيميائيون العرب في أول اشتغالهم بهذا العلم من الاضطهاد والمصاعب، وذكر أن جابر خلص من الموت مراراً، كما أنه قاسى من انتهاك الجهلاء لحرمته ومكانته، وأنه اضطر إلى الافضاء ببعض أسرار الطبيعة إلى هارون الرشيد، ويحيى البرمكي وابنيه، وأن ذلك هو السبب في غناهم وثروتهم [68].
وإذا رجعنا إلى رسائل جابر، نجده يذكر معلومات سبقت عصره بقرون، من ذلك تلك الفكرة الهائلة التي أيدتها التجارب اليوم، من ان الجوهر البسيط يشبه العالم الشمسي. بالاضافة إلى ذلك قد يكون الاكسير الذي سعى جابر إلى التوصل اليه، هو اليوم نفسه عنصر (الراديوم)، أو احد الاجسام المشعة، نظراً لنص وضعه البيروني – العالم الاسلامي الكبير في الطبيعة – كما بيّن ذلك إذاعة راديو لندن في 17 نيسان عام 1945، ونشرته مجلة المستمع العربي (سنة 6 عدد 6 )، بعنوان (الراديوم وعلماء العرب )، وجريدة الكيمياء الالمانية في هيدلبرغ – آذار 1958 .
وذكر ذلك في مؤتمر العلوم الدولي الثامن (ذكره مؤلف الكتاب) [69].
وهكذا نرى أن جابراً شخصية فذة، جمعت بين الحكمة والفلسفة والطب والمنطق والتصوف، إلى جانب علم الصنعة، وأن عالماً مثله يؤلف أكثر من 3900 كتاب في علوم جلّها عقلية وفلسفية، لهو حقاً من عجائب الدهر [70].
ولما توفي جابر بالرحبة، قال أبو فراس يرثيه:
بنفسي على جابر حسرة تزول الجبال وليست تزول
له ما بقيت طويل البكاء وحسـن الثناء وهذا قليل [71]
وقيل في جابر أيضاً:
هذا الذي بمقــاله غر الاوائـل والاواخر
ما كنت إلا كاسراً كذب الذي سماك جابر [72]
وأخيراً نقول … مما لاشك فيه، أن جابراً عبقرية علمية بارزة في علم الكيمياء، وكان تأثيره واضحاً وكبيراً في أوربا في القرون الوسطى حتى القرن الثامن عشر، عندما ظهر لافوازييه وغيره.
ولم يقف جابر عند الاراء النظرية فقط كما فعلت الامم القديمة، وإنما دخل المختبر، واجرى التجارب وربط الملاحظات على أسس علمية، وهي الاسس التي بنى عليها العلم الحديث منجزاته في هذا الميدان وفي غيره من الميادين الاخرى [73].
لكن على الرغم من هذه الجهود التي بذلها العلماء العرب، والمواد التي توصلوا إليها، والعمليات التي مارسوها، فإنهم لم يهتدوا إلى القوانين التي تضبط العمليات الفيزيائية، ولم يضعوا للكيمياء قوانين عامة، أو رموزاً تدل عليها، فهذه أمور كانت وليدة الكيمياء الحديثة [74].
المراجع والحواشي
[1] - جابر. بهزاد - الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – بيروت. دار مصباح الفكر 1986 م ، ص61.
[2] - جابر. بهزاد - الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص61.
[3] - نفس المصدر السابق ص61.
[4] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – دار العلم للملايين – بيروت ، 1970 ، ص79.
[5] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الخيمياء – دار الأضواء ، بيروت. الغبيرة ، طبعة 1986 ، ص 435.
[6] - ابن النديم – الفهرست – تعليق الشيخ ابراهيم رمضان ، (دار الفتوى ) بيروت. دار المعرفة ، طبعة أولى 1994 ، ص435.
الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص188.
11 - نفس المصدر السابق ، ص189.
[8] - جابر. بهزاد - الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص62.
[9] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص29.
[10] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص243.
[11] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص30.
[12] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص243.
[13] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص30.
[14] - نفس المصدر السابق ، ص31.
[15] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – المجلد الرابع ، حققه حسن الامين ،
دار التعارف للمطبوعات ، بيروت. 1986 ، ص32.
[16] - نفس المرجع السابق ص32 ، بالاضافة إلى مرجع د. هاشمي ص31.
[17] - الأمين النديم – الفهرست – ص435.، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص31
[18] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص248. بالاضافة إلى كتاب
الفهرست ص435 ، وكتاب أعيان الشيعة للامام السيد محمد الامين ص30.
[19] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص31.
[20] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص261.
[21] - تاتون. رينيه – تاريخ العلوم العام (العلم القديم والوسيط من البدايات حتى سنة
1450م) ، ترجمة د. على مقلد. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،طبعة أولى 1988 ص439.
[22] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص33.
[23] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص263.
[24] - نفس المصدر السابق ، ص263.
[25] - دائرة المعارف الاسلامية. إصدار أئمة من المستشرقين ، النسخة العربية: د. ابراهيم
خورشيد ، أحمد الشنتاوي ، د. عبد الحميد يونس. دار البعث ، المجلد العاشر ،ص205.
[26] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص266.
[27] - نفس المصدر السابق ، ص266.
[28] - نفس المصدر السابق ، ص267.
[29] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص243.
[30] - نفس المصدر السابق ، ص244.
[31] - نفس المصدر السابق ، ص245.
[32] - سيزكين. فؤاد – تاريخ التراث العربي ج4 – ترجمة د. عبدالله حجازي ،
السعودية ، طبعة أولى 1986 ، ص365.
[33] - دائرة المعارف الاسلامية. إصدار أئمة من المستشرقين ، النسخة العربية ، ص202.
[34] - نفس المصدر السابق ، ص204.
[35] - سيزكين. فؤاد – محاضرات في تاريخ العلوم العربية والاسلامية – منشورات العلوم
العربية والاسلامية – سلسلة أ ، مجلد (1) 1984 ، ص62.
[36] - دائرة المعارف الاسلامية. إصدار أئمة من المستشرقين ، النسخة العربية ، ص202.
[37] - نفس المصدر السابق ، ص202 – 203.
[38] - نفس المصدر السابق ، ص203.
[39] - نفس المصدر السابق ، ص203.
[40] - ابن النديم – الفهرست – ص435 ، بالاضافة إلى المرجع: أعيان الشيعة للسيد
محمد الأمين ، ص32.
[41] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص32.
[42] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص198.
[43] - نفس المصدر السابق ، ص199 ، بالاضافة لكتاب: أعيان الشيعة للسيد محمد
الأمين ، ص34.
[44] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص199.
[45] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص267- 268.
[46] - نفس المصدر السابق ، ص266.
[47] - الأمين ، الأمام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص 30.
[48] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص65.
[49] - نفس المصدر السابق ، ص65.
[50] - ابن النديم – الفهرست – ص436.
[51] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص37- 39 بالاضافة إلى كتاب
مختار رسائل جابر لـ كراوس .
[52] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص36.
[53] -نفس المصدر السابق ، ص36.
[54] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص273 ،
بالاضافة لمرجع جابر. بهزاد – الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص68.
[55] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص247.
[56] - نفس المصدر السابق ، ص253.
[57] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص277.
[58] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص251.
[59] - فروح. عمر _ تاريخ العلوم عند العرب – ص251.
[60] - نفس المصدر السابق ، ص63.
[61] - نفس المصدر السابق ، ص63.
[62] - نفس المصدر السابق ، ص502.
[63] - الزركلي. خير الدين – الأعلام – ج2 ، ص90 – 91.
[64] - نفس المصدر السابق ، ص91
[65] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص29 –30.
[66] - نفس المصدر السابق ، ص51.
[67] - سيزكين. فؤاد – محاضرات في تاريخ العلوم العربية والاسلامية – ص63.
[68] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص31.
[69] - الهاشمي. د. محمد يحيى – الامام الصادق ملهم الكيمياء – ص198.
[70] - الأمين ، الامام السيد محمد – أعيان الشيعة – ص30
[71] - نفس المصدر السابق ، ص30
[72] - نفس المصدر السابق ، ص36.
[73] - عبد الرحمن. حكمت نجيب – دراسات في تاريخ العلوم عند العرب – ص268.
[74] - جابر. بهزاد – الكافي من تاريخ العلوم عند العرب – ص 67.
وشكرا
مع تحياتي
ملك البلاد








 إذا شعر المصاب برغبة في التقيؤ أو بدأ بذلك مثل حالات الغرق, عندها يجب وضع المصاب على جنبه لتسهيل خروج القيء ثم ينظف فم من الفيء أو أي عوالق.
إذا شعر المصاب برغبة في التقيؤ أو بدأ بذلك مثل حالات الغرق, عندها يجب وضع المصاب على جنبه لتسهيل خروج القيء ثم ينظف فم من الفيء أو أي عوالق.