سورة الفاتحة
سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن ولقد ورد في شأنها أحاديث كثيرة وصنف العلماء في فضائلها.. ونظرا لأهمية هذه السورة في القرآن سنحاول أن نأتي ببعض الفوائد والنكت المحيطة بها فيما يخص اللغة والنحو دون إطناب ودون التطرق لما يخص جانب التفسير.
حديث في فضل سورة الفاتحة:
عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : ( كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأتيته ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ قال : قلت : يا رسول الله إني كنت أصلي، قال : ألم يقل الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ}. ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ، قال : فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله، إنك قلت : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال : نعم : {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). أخرجه أحمد ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
أسماء سورة الفاتحة[1]:
سورة الفاتحة مكية ، وهي سبع آيات بلا خلاف . وأسماؤها :
1- أم القرآن : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فهي خداج ، خداج ، خداج ، غير تمام) .
2- أم الكتاب : قال البخاري : وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة .
3- السبع المثاني : لقول الله تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} .
4- القرآن العظيم : لقوله تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} .
ودليل هذه الأسماء الأربعة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله رب العالمين: أم القرى، وأم الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم).
5- فاتحة الكتاب : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
ولأنها يُفتح بها القراءة في الصلاة .
6- الصلاة : لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه :
( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله : حمدني عبدي) .... الحديث . فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها.
7- الحمد : لقول الله تعالى : {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}
8- الرقية : لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد : ( وما يدريك أنها رقية) .
9- أساس القرآن : سماها ابن عباس .
10- الواقية : سماها سفيان بن عُيينة .
11- الكافية : سماها يحي بن كثير .
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم: كل الحروف مرققة، السين ساكنة، فيها رخاوة وهمس وصفير، أوجه الوقف على الكلمة اثنان لأنها مجرورة، وجه بالسكون وحينها تصير الميم ساكنة فيها توسط وفي رابع درجات الغنة، ووجه بالروم وتصير متحركة في أدنى درجات الغنة.
إعرابها: بسم: جار ومجرور متعلق بمحذوف، والباء هنا للاستعانة أو للإلصاق، وتقدير المحذوف: أبتدئ، فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به مقدم، أو تقديره: ابتدائي، فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف.
فائدة لغوية: "الْبَاءُ فِي : بِسْمِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ ; فَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ الْمَحْذُوفُ مُبْتَدَأٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ خَبَرُهُ ، وَالتَّقْدِيرُ ابْتِدَائِي بِسْمِ اللَّهِ؛ أَيْ كَائِنٌ بِاسْمِ اللَّهِ؛ فَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْكَوْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: الْمَحْذُوفُ فِعْلٌ تَقْدِيرُهُ ابْتَدَأْتُ، أَوْ أَبْدَأُ، فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِالْمَحْذُوفِ، وَحُذِفَتِ الْأَلِفُ مِنَ الْخَطِّ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، فَلَوْ قُلْتَ لِاسْمِ اللَّهِ بَرَكَةٌ أَوْ بِاسْمِ رَبِّكَ ، أَثْبَتَّ الْأَلِفَ فِي الْخَطِّ.
وَقِيلَ حَذَفُوا الْأَلِفَ; لِأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى سِمٍ، وَهِيَ لُغَةٌ فِي اسْمٍ .
وَلُغَاتُهُ خَمْسٌ : سِمٌ بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا ، اسْمٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا ، وَسُمَى مِثْلُ ضُحَى .
وَالْأَصْلُ فِي اسْمٍ: سُمُوٌ فَالْمَحْذُوفُ مِنْهُ لَامُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي جَمْعِهِ أَسْمَاءُ وَأَسَامِي وَفِي تَصْغِيرِهِ «سُمَيٌّ» وَبَنَوْا مِنْهُ فَعِيلًا، فَقَالُوا فُلَانٌ سَمِيُّكَ: أَيِ اسْمُهُ كَاسْمِكَ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ سَمَّيْتُ وَأَسْمَيْتُ؛ فَقَدْ رَأَيْتَ كَيْفَ رَجَعَ الْمَحْذُوفُ إِلَى آخِرِهِ . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: أَصْلُهُ وَسَمَ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَسْمِ، وَهُوَ الْعَلَامَةُ وَهَذَا صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فَاسِدٌ اشْتِقَاقًا. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أُضِيفَ الِاسْمُ إِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ هُوَ الِاسْمُ ؟ .
قِيلَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الِاسْمَ هُنَا بِمَعْنَى التَّسْمِيَةِ، وَالتَّسْمِيَةُ غَيْرُ الِاسْمِ; لِأَنَّ الِاسْمَ هُوَ اللَّازِمُ لِلْمُسَمَّى، وَالتَّسْمِيَةُ هُوَ التَّلَفُّظُ بِالِاسْمِ. وَالثَّانِي: أَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ، تَقْدِيرُهُ بِاسْمِ مُسَمَّى اللَّهِ. وَالثَّالِثُ أَنَّ اسْمًا زِيَادَةٌ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَقَوْلُ الْآخَرِ: دَاعٍ يُنَادِيهِ بِاسْمِ الْمَاءِ أَيِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا، وَنُنَادِيهِ بِالْمَاءِ."[2]
الله: الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتحذف دَرْجا، وهي مفتوحة لأنها اتصلت بلام التعريف، ولام التعريف شمسية، أدغمت في اللام للتماثل وفيها توسط، وهي مرققة في لفظ الجلالة لأن ما قبلها مكسور، باقي الحروف مستفلة، المد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا، أوجه الوقف أربعة لأن الكلمة مجرورة، ثلاثة بالسكون المحض 2-4-6، ووجه بالروم.
إعرابها: الله: لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.
فائدة لغوية: قال محيي الدين في إعراب القرآن: " (الله) علم لا يطلق إلا على المعبود بحقّ خاص لا يشركه فيه غيره وهو مرتجل غير مشتق عند الأكثرين واليه ذهب سيبويه في أحد قوليه فلا يجوز حذف الألف واللام منه وقيل: هو مشتق وإليه ذهب سيبويه أيضا ولهم في اشتقاقه قولان:
آ- أن أصله إلاه على وزن فعال من قولهم: أله الرّجل يأله إلاهة أي عبد عبادة ثم حذفوا الهمزة تخفيفا لكثرة وروده واستعماله ثم أدخلت الألف واللام للتعظيم ودفع الشّيوع الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة من دون الله.
ب- أن أصله لاه ثم أدخلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تستر كأنّه، سبحانه، يسمّى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار وما أجمل قول الشريف الرّضي الشاعر:
«تاهت العقلاء في ذاته تعالى وصفاته، لاحتجابها بأنوار العظمة. وتحيّروا أيضا في لفظ الجلالة كأنه انعكس إليه من تلك الأنوار أشعة بهرت أعين المستبصرين، فاختلفوا: أسريانيّ هو أم عربي؟ اسم أو صفة؟ مشتقّ وممّ اشتقاقه؟ وما أصله؟ أو غير مشتق؟ علم أو غير علم؟»[3].
وقال صاحب التبيان: " وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ : هَمْزَةُ إِلَاهٍ حُذِفَتْ حَذْفًا مِنْ غَيْرِ إِلْقَاءٍ ، وَهَمْزَةُ إِلَاهٍ أَصْلٌ ; وَهُوَ مِنْ أَلِهَ يَأْلَهُ إِذَا عُبِدَ ، فَالْإِلَهُ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْمَأْلُوهِ ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ .
وَقِيلَ أَصْلُ الْهَمْزَةِ وَاوٌ ; لِأَنَّهُ مِنَ الْوَلَهِ ، فَالْإِلَهُ تَوَلَّهُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ ; أَيْ تَتَحَيَّرُ .
وَقِيلَ أَصْلُهُ لَاهُ عَلَى فَعِلَ ، وَأَصْلُ الْأَلِفِ يَاءٌ ; لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي مَقْلُوبِهِ لَهِيَ أَبُوكَ ثُمَّ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ."[4]
الرحمن: الراء مفخمة وباقي الحروف مرققة، الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتحذف درجا، وهي مفتوحة لأنها اتصلت بلام التعريف، ولام التعريف هنا شمسية وأدغمت في الراء لعلة التقارب على مذهب من جعل المخارج سبعة عشر (مذهب الجمهور وابن الجزري) وكذلك على مذهب من جعلها ستة عشر (وهو مذهب سيبويه والشاطبي ومن وافقهما)، وأما على مذهب من جعلها أربعة عشر مخرجا (وهو مذهب الفراء وقطرب وجماعة من أهل العربية، فيوافقون سبويه ويجعلون اللام والراء والنون من مخرج واحد) فعلى هذا المذهب تكون علة الإدغام التجانس. الحاء ساكنة فيها رخاوة وهمس، المد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. أوجه الوقف أربعة لأن الكلمة مجرورة، ثلاثة بالسكون المحض 2-4-6 وحينها النون تكون ساكنة فيها توسط وغنة من الدرجة الرابعة، ووجه بالروم وحينها النون متحركة وفيها غنة من الدرجة الخامسة.
إعرابها: الرحمن: صفة لله تعالى تتبع موصوفها في الجر وعلامته الكسرة الظاهرة في آخره.
فائدة لغوية: قال في إعراب القرآن: " (الرَّحْمنِ): صيغة فعلان في اللغة تدل على وصف فعليّ فيه معنى المبالغة للصفات الطارئة كعطشان وغرثان"[5].
الرحيم: الراء مفخمة وباقي الحروف مرققة، الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتحذف درجا، وهي مفتوحة لأنها اتصلت بلام التعريف، ولام التعريف هنا شمسية وأدغمت في الراء لعلة التقارب على مذهب من جعل المخارج سبعة عشر أو ستة عشر، وأما على مذهب من جعلها أربعة عشر مخرجا فالعلة التجانس. المد طبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا. أوجه الوقف أربعة لأن الكلمة مجرورة، ثلاثة بالسكون المحض 2-4-6، ووجه بالروم.
إعرابها: الرحيم: صفة لله تعالى تتبع موصوفها في الجر وعلامته الكسرة الظاهرة.
فائدة لغوية: قال في اعراب القرآن: " (الرَّحِيمِ) صيغة فعيل تدل على وصف فعليّ فيه معنى المبالغة للصفات الدائمة الثابتة ولهذا لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر."[6]
قال في التبيان: " (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) صِفَتَانِ مُشْتَقَّتَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَالرَّحْمَنُ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ. وَفِي الرَّحِيمِ مُبَالَغَةٌ أَيْضًا؛ إِلَّا أَنَّ فَعْلَانًا أَبْلَغُ مِنْ فَعِيلٍ. وَجَرُّهُمَا عَلَى الصِّفَةِ، وَالْعَامِلُ فِي الصِّفَةِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَوْصُوفِ.
وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْعَامِلُ فِيهَا مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ كَوْنُهَا تَبَعًا وَيَجُوزُ نَصْبُهُمَا عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي، وَرَفْعُهُمَا عَلَى تَقْدِيرِ هُوَ."[7]
وجملة البسملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب
فوائد بلاغية في البسملة:
"في البسملة طائفة من فنون البلاغة:
آ- الأولى في متعلق بسم الله أن يكون فعلا مضارعا لأنه الأصل في العمل والتمسّك بالأصل أولى ولأنه يفيد التجدّد الاستمراري وإنما حذف لكثرة دوران المتعلق به على الألسنة وإذا كان المتعلق به اسما فإنه يفيد الديمومة والثبوت كأنما الابتداء باسم الله حتم دائم في كل ما نمارسه من عمل ونردده من قول.
ب- الإيجاز بإضافة العام إلى الخاص ويسمى إيجاز قصر.
ح- إذا جعلنا الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مكنية تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به وإذا جعلنا الباء للإلصاق فيكون في الكلام مجاز علاقته المحلية نحو مررت بزيد أي يمكان يقرب منه لا يزيد نفسه."[8]
وقال صاحب الجدول: " 1- التكرير: لقد كرّر اللّه سبحانه وتعالى ذكر الرحمن الرحيم لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج وقد ذكر المنعم دون المنعم عليهم فأعادها مع ذكرهم وقال: «ربّ العالمين الرحمن» بهم أجمعين.
2- قدم سبحانه الرحمن على الرحيم مع أن الرحمن أبلغ من الرحيم، ومن عادة العرب في صفات المدح الترقي في الأدنى الى الأعلى كقولهم: فلان عالم نحرير. وذلك لأنه اسم خاص باللّه تعالى كلفظ «اللّه» ولأنه لما قال «الرحمن» تناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها، وأردفه «الرحيم» كتتمة والرديف ليتناول ما دقّ منها ولطف. وما هو من جلائل النعم وعظائمها وأصولها أحق بالتقديم مما يدل على دقائقها وفروعها. وافراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحريك سلسلة الرحمة.
فباسم اللّه تعالى تتم معاني الأشياء ومن مشكاة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تشرق على صفحات الأكوان أنوار البهاء" [9]
وفي إعراب القرآن: "يقال لمن قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: مبسمل وهو ضرب من النحت اللغوي وقد ورد ذلك في شعر لعمر بن أبي ربيعة:
لقد بسملت ليلى غداة لقيتها ... فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل
ومثل بسمل حوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله وهيلل إذا قال: لا إله إلا الله وسبحل إذا قال: سبحان الله وحمدل إذا قال: الحمد لله وحيصل وحيعل إذا قال: حي على الصلاة وحي على الفلاح وجعفل إذا قال: جعلت فداك.
هذا والنحت عند العرب خاص بالنسبة أي أنهم يأخذون اسمين فينحتون منهما اسما واحدا فينسبون إليه كقولهم: حضرميّ وعبقسيّ وعبشيّ نسبة إلى حضرموت وعبد القيس وعبد شمس." [10]
يبقى أن فوائد البسملة كثيرة جدا ومبسوطة في كتب التفسير والفقه لمن أراد الإحاطة بكل معانيها ومواطن التعبد بها.
----------------------------------
[1] تفسير وبيان لأعظم سورة في القرآن، لمحمد بن جميل زينو.
[2] التبيان في إعراب القرآن للعلامة محب الدين العكبري الجزء الأول ص11
[3] إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش ص23-24.
[4] التبيان في إعراب القرآن للعلامة محب الدين العكبري الجزء الأول ص11
[5] إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش ص23-24.
[6] إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش ص23-24.
[7] التبيان في إعراب القرآن للعلامة محب الدين العكبري الجزء الأول ص11
[8] إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش ص24.
[9] "الجدول في إعراب القرآن"، محمود صافي، ص22.
[10] إعراب القرآن الكريم، محيي الدين الدرويش، ص 25-26.




 فأصل الكلمة "تأمننا" بنونين، أدغمت الأولى في الثانية للجميع.
فأصل الكلمة "تأمننا" بنونين، أدغمت الأولى في الثانية للجميع. 
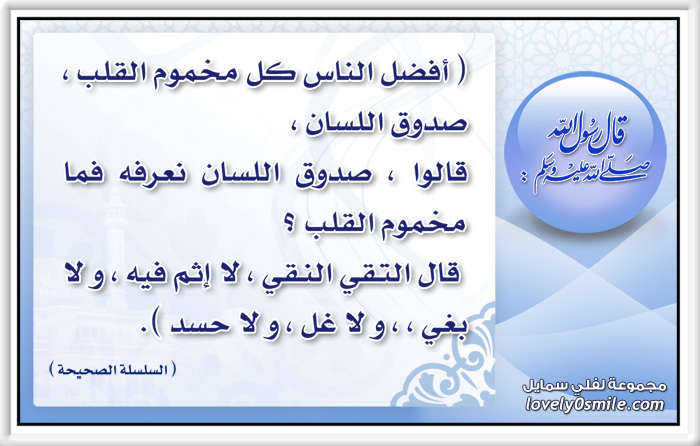

 بالبقرة.
بالبقرة.  حيث وقع.
حيث وقع. 

.jpg)